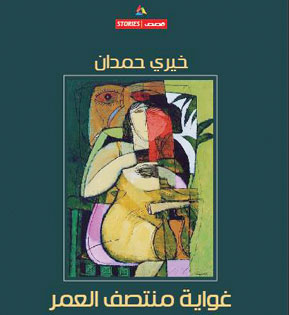
قصة قصيرة

خيري حمدان
من مجموعة غواية منتصف العمر
شعرتُ بالاختناقِ حالَ صُعودي إلى الحافلة، كنتُ أوّلُ الركّابِ وكانَ الجوُّ خانقاً حاراً بالرغمِ منْ بدايةِ شهر نوفمبر واقترابِ موسم الشتاءِ في عمّان. فتحتُ النافذةَ لأسمحَ لتيارِ الهواءِ الراكدِ بالحركة، لكنَّ الأثرَ كانَ محدوداً. بعدَ لحظاتٍ دخلَ رجلٌ يحملُ بينَ يديهِ طفلاً يبلغُ منَ العمرِ سنتان. الصغيرُ ناعسٌ ومتوتّر، هذا لمْ يمنعْهُ بالطبعِ من الضغطِ على اللعبةِ الصغيرةِ بينَ يديه، لتنطلقَ نغمة مفبركة حادّة تشبِهُ الموسيقى. استمرّ الضغط على اللعبةِ وبقيتْ أعصابي مشدودة طوالَ معظمِ الطريق، بلْ وأوشكتُ لأكثرَ منْ مرّةٍ على مغادرةِ الحافلة، لكنّني مدركٌ بطبيعةِ الحالِ بأن لا مفرَ من هذا النمطِ من الإزعاجِ في أيّةِ حافلةٍ أخرى.
كثافة السكانِ جعلتْ مَلْءَ الحافلةِ بالركابِ أمراً سهلاً للغاية، لم تمضِ سوى دقائق حتّى امتلأت المقاعد بالركاب، بل ووافقَ البعضُ على السفر وقوفاً وسطَ الحافلة، بدلاً منِ انتظارِ حافلة أخرى. يومُ جمعةٍ دافئ، وأمامي ساعة ونصف الساعة لأصلَ لموعدي. نعم، هذه المرّةَ لن أتأخر، سأصلُ في الوقتِ المحدّد تماماً. الكرسيُ إلى جانبي فرغَ لبعضِ الوقتِ، دخلت فتاةٌ في مقتبلِ العمرِ، تردّدت كثيراً “هل تجلسُ إلى جانبي أم تنتظر مكاناً بجانبِ سيدة أخرى؟”، شككتُ في بدايةِ الأمرِ برائحةِ جسدي الخاصة، لكنّي أضعُ عطراً لطيفاً خفيفاً كلّما قررتُ الذهابَ في رحلاتٍ قصيرة، كما إنّني منَ الوزنِ الخفيفِ مقارنة بأهلِ البطونِ المترجرجةِ، ولن أضايقَ الفتاةَ بكتلٍ لحميةٍ فائضة، مع هذا أصرّت على البقاء واقفة، وسرعانَ ما أنقذَ الموقفَ شابٌ رجاها بأنْ تجلسَ في مكانٍ ما في الخلفِ. شعرتُ في تلكَ اللحظةِ بأنّ ثقتي بنفسي قد تراجعتْ، بيدَ أنّ صوتَ الضميرِ همسَ مهدّئاً من قلقي “يا صديقي، إنّه الربيعُ العربيّ”.
باتتِ الرحلة القصيرة أكثرَ راحةٍ بعدَ أنْ نامَ الطفلُ وصمتتِ الدمية اللئيمة بينَ يديه. في منتصفِ المسافة، دقّ مسافرٌ الجرسَ الصامت، أضاءَت بعضُ الأنوارِ الخافتةِ للغاية، ولمْ يلحظْها السائقُ الأحمق، منَ المتعارفِ عليهِ توظيف فتية في هذه الحافلات لجبْيِ النقودِ ومساعدةِ السائقِ للتوقفِ وفتحِ الأبواب والانطلاق ثانية، لكنَّ هذا السلوك قد تراجعَ مؤخّراً، وباتَ التعاملُ محصوراً معَ السائقِ فقَط، ما يتسبّب ببعضِ الصعوباتِ بينَ الحينِ والآخرَ، السببُ في ذلك غالباً هوَ الطمع، لأنّ ما يحصلونَ عليه منْ دخلٍ يسمحُ بتوظيف فتىً ليقتاتَ هوَ الآخر بما تجودُ بهِ نفسُ السائق. لم تتوقفِ الحافلة في المكانِ الذي رغبَ المسافرُ الهبوطَ فيه، صاحَ الرجلُ بكلّ ما أوتي منْ قوّةٍ “أليستْ هذه الأجراس بهدف الوقوفِ يا رجلْ؟”. سمعَ السائقُ الكلمات الغاضبة واللهجةَ الاستفزازيّة. لمْ يتوقفْ على الفور، وابتعدتِ الحافلة لعشراتِ الأمتار الإضافيّة بعيداً عن المكان. رفضَ الرجلُ التوجّه للسائق وطلبَ منه بجلافةٍ واضحةٍ أنْ يفتحَ البابَ الأوسَط ثمّ رمى له بدينار، معَ أنَّ أجرتَه تبلغُ حوالي الدينارَيْن. (السائقُ بالعادة يفتح الباب الأماميّ فقط عند الهبوط كيْ يحصل على أجره دون وسيط) اشتاط السائقُ الأحمقُ غيظاً وهبط من الحافلة يصرخ على الرجلِ كيْ يدفعَ باقي أجرَه، الأخيرُ قالَ بأنّه يحتاج لعربةِ أجرةٍ كيْ يعود إلى المكان المطلوب خاصّة وأنّ برفقته إناث. لم يتعودنَ الحركةَ والتنقل، كما هو حالُ غالبية النساءِ في المشرق.
ليس بإمكان معظم ركاب الحافلة مغادرتها لأنّ البابَ الأماميّ مزدحمٌ بالمتطفلين، كنتُ أرغبُ بأنْ أساهم في حلّ الخلاف. فتحتُ النافذة على مصراعَيْها ورأيت كتلاً بشريّة متلاحمة، بعد لحظاتٍ ظهرَ جسدُ السائقِ الهزيلِ منْ بينِ قبضةِ الرجلِ الهائجِ والدمُ يسيلُ منْ أصلِ أنفِهِ بالقربِ من العين اليمنى. كان على وشك البكاء من هولِ المفاجأةِ والإهانَةِ التي أصابتْه، لكن لا عودة عن المحظور. أبعدَ مجموعة من الرجال صاحبنَا الهائجِ وعادَ السائقُ يمسح الدم عنْ وجهِه. أدارَ المحرّك وبعدَ أمتارٍ وقفَ لتصعدَ مجموعة أخرى منَ الركاب. كانَ علينا الانتظار لأنّ أحدَ الركّابِ مُقْعَدٌ وبحاجَةٍ لحملِه إلى داخل الحافلة، ثمّ طيّ العربة ونقلها إلى الممر العام في الحافلة. لمْ تعد الرحلة مملّة كما كانتْ عليها في البداية، أصبحَ بإمكاني التحقّقَ من الواقع الملموس للشعب، بعد غيابٍ استمرّ لأقلّ من عامَيْن. أدركتُ بأنّ طقوسَ الحضارةِ تنقصُنا وكذا احترام الذات. جلس المُقعَدُ، أمّا مساعدوه الفِتْيَة وعلى الأرجح أخوته، فقد أخذوا يقذفونَ بين أيديهم كيساً صغيراً يحتوي ماءً. اندلقَ الماءُ من الكيسِ البلاستيكيّ الصغير. قالَ المُقْعَدُ محذّراً “السَمَكَة!”. نعم، بقيَ بعضُ الماءِ لاستمرار السمكة الأسيرة حيّة بينَ أيدي الفتيةِ، ولكنْ ليسَ طويلاً على الأرجح. أمسكَ أحدُهُم السمكةَ عبرَ الكيسِ وضغط عليها ضاحكاً، همسَ لصاحبِهِ بأنّه يسمعُ طقطقةَ كيانِها بين يديه، ثمّ أصيبَ بالمللِ ورمى بالكيسِ الصغير خارج الحافلة، نظرتُ مجدّداً من النافذة التي أصبحت بمثابةِ بوابتي نحوَ هذا العالم، رأيتُ الكيسَ الصغير يتقاذَفُ في مكانِه قبلَ أنْ يهدأ بموتِ السمكة. بقي أمامنا بعض الوقت كيْ ننتَهي من هذه الرحلة. أشعلَ أحدُ المسافرين لفافة تبغٍ، وهو يعرفُ جيّداً بأنّ التدخينَ ممنوعٌ طِوالَ الرحلة. كانَ يتلفّتُ ذات اليمين واليسار تحسباً منْ ردود فعل سائق الشاحنَةِ أوِ الركّاب. سقطتْ جمرةُ السيجارة على المقعدِ الجلديّ قبلَ أن نصل بأمتار، واشتعلتِ النيرانُ بالجلدِ. فُتِحَ البابُ الأماميّ للحافلة وتدافعَ الركّابُ إلى خارجِها، عندها قررتُ أنْ أقفزَ من النافذة، كانتْ حقيقة بمثابة الخلاصِ إلى العالمِ الخارجيّ. تمكّن السائقُ من إطفاءِ النيران وسارع آخرونَ للسيطرةِ على الحريق. استمرّ الصراخُ والشتامُ لدقائق قبل أنْ تحضرَ دورية أمنٍ كانت في الجوارِ للتحقيق في ملابساتِ الحريق.