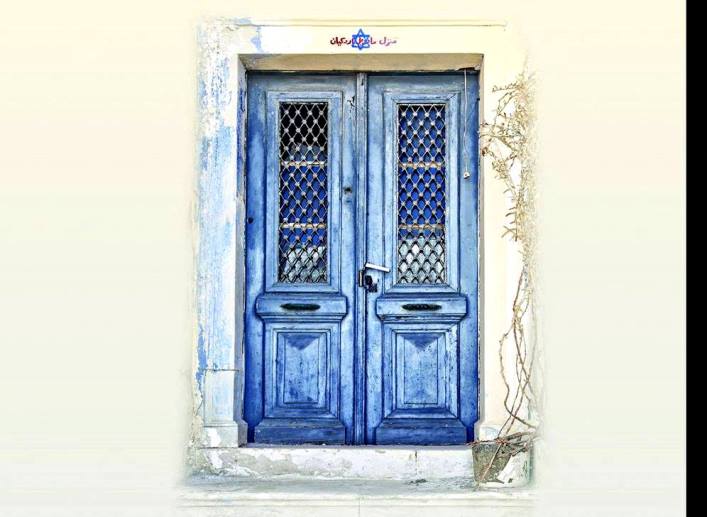
ككثيرين، فرحتُ بفوز فلسطين بجائزة ما، بغض النظر عن ملاحظاتي على جائزة البوكر السنوية، ومعاييرها الأدبية والتقييمية لمستوى الأعمال الأدبية المشاركة.
اشتريتُ نسختين من رواية "مصائر: كونشيرتو الهولوكوست والنكبة" – للفلسطيني ربعي المدهون، أهديتُ إحداها لصديقة، والثانية لأقرأها، فنتناقش فيها لاحقاً.
قالت صديقتي من سيقرأ الرواية سيُحبُّ فيها أمراً واحداً فقط؛ جرأةُ كاتبها ووضوحُ دعوتِه لنا أنه بالإمكان نسيان حق العودة، وبالإمكان العيش المشترك مع الإسرائيلي، وأنه بالإمكان التعاطف مع فكرة أن الإسرائيلي هو ضحيةٌ الهولوكوست النازي، هو مثلنا ضحية.
هكذا كما قالت صديقتي، يقول بطل الرواية في واحدٍ من مشاهدها، حين يُصر على زيارة متحف الهولوكست المطل على بقايا قرية دير ياسين، التي حسمت مذبحتُها احتلال أرضنا في عام 1948، فيقول:
".. بدي أشوف دير ياسين من هناك. بدي أشوف كيف الضحايا بشوفوا الضحايا." (ص 182، ط 1، 2015).
أسلوب الخداع الروائي
كُتِبَت الروايةُ بأسلوبٍ واقعي مخادعٍ غير موهوب، وهي تُحاولُ تصوير واقع الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين التي احتلت عام 1948، على أنه واقعٌ مأساوي، يقوم على التفرقة والتمييز العنصري، وهذه الغايةُ تنفيها سردية الرواية في مواقف الشخصيات ودلالات استخداماتها اللغوية لبعض المفردات والكلمات.
إذ تجيء غايات الرواية مخالفة لما أفصح عنه كاتبها، في مقدمة لا لزوم لها، حين يقول إن:
"هذه روايةٌ عن فلسطينيين بقوا في وطنهم بعد حرب عام 1948، وأصبحوا، بحكم واقع جديد نشأ، مواطنين في دولة إسرائيل ويحملون "جنسيتها" في عملية ظلم تاريخية نتج عنها "انتماء" مزدوج، غريب ومتناقض لا مثيل له، وهي رواية عن آخرين أيضاً، هاجروا تحت وطأة الحرب ويحاولون العودة بطرق فردية". (ص79، ط 1، 2015).
الروايةُ تُروِّجُ لمجموعة من الأفكار الصادمة لقارئ فلسطيني لا يستطيع تقبل فكرة أن يوصف بـ "التيس"، كما يصفهُ المدهون وكما سنوضح لاحقا، وتلك الأفكار من قبيل:
إسقاط حق العودة
كل من يُفكر في حقه في العودة إلى أرضه التي هُجِّر منها، يرى المدهون أن بإمكاننا تسميتُه بـ "الفلسطيني التيس"، هكذا يفتَتِحُ الفصل الثاني من الرواية، أو كما يُسميها المدهون "الحركة الثانية" في الصفحة 71، بعنوان "الفلسطيني التيس"، والمقصودُ به، كل فلسطيني يُقرر العودة كما فعل باسم الذي قرر العودة إلى يافا بلد زوجته "جنين" التي تعرف إليها عبر العالم الافتراضي حينما كان مقيماً في نيويورك.
فتستذكرُ "جنين" باسم عائداً من وزارة الداخلية في تل أبيب:
"لاحقتهُ مخيِّلتُها عائداً إلى البيت من شارعِ البحر، يجر حصته من الخيبة (...) يُلاكمُ الهواء ويلعنُ السنة التي عاد فيها إلى البلاد ظاناً أنها وطن، بينما رأسهُ يُجادلُ حيطان مسجد البحر." (ص71، ط 1، 2015)
أما "الفلسطيني التيس" الثاني، فهو السيد "باقي هناك"، الذي قرر العودة إلى أرض وطنه، فيُهينُه ابنه، لأنه عاد، قائلاً:
"فش فايدة، أبوي تيس، وراسه ناشف...العفريت ما بيعمل عمايله." (ص79، ط 1، 2015)
وعندما يُمرر المدهون السُّبة لنا لمجرد التفكير بالعودة فإنه يؤكد في الجهة المقابلة:
تلك هي الخلاصةُ التي تتسللُ إلى القارئ، من بطلةُ الرواية "جولي" وهي البريطانية ابنة الضابط في جيش الانتداب البريطاني التي هربت والدتها الأرمنية الفلسطينية معه وعاشت معه في بريطانيا.
جولي تُلحُ على العودة، فيما يبدو زوجها وليد (بطل الرواية) مُتردداً بل ويعلن في أحد المشاهد رفضه ُلفكرة "جولي" التي طرحتها عليه في أن يشتريا بيتا في عكا مسقط رأس والدتها، ويقيما فيه، أو بيتاً في مسقط رأسه، في المجدل في عسقلان فيقولُ وليد:
"هذه ليست عودة جيجي. أنا لن أعود إلى البلاد لكي أعيش فيها غريباً. عندما نصل إلى لندن نناقش الموضوع بعيداً عن ضغط لحظةِ الفراق هذه." (ص79، ط 1، 2015)
حتى محاولات الكاتب، في التخفيف من وقع مفاجأته لنا بأن الفلسطيني لا يرغب في العودةِ لأرضه، وأنه إن عاد سيكون غريباً، لا تأتي إلاَّ على لسان من كانت حبيبته؛ اليهودية لودا، التي تقاسم حبها مع صديقه الأعز، ففاز بها "جميل" زوجة له، في محاولةٍ لتبرئةِ الإسرائيلي المحتل وعدم تحميله مسؤولية رفضه لحق الفلسطيني في العودة، فـ "لودا" هي التي تُقدِّمُ المفهوم المشوَّه لإمكانية عودة كل فلسطيني يرغب في ذلك، وكأنه أمرٌ لا عائق أمامه، فبعد أقل من 6 أسطر على إعلان رفض وليد العودة تقولُ لودا:
"مأكول (معقول) ونص وليد.. وليش لا. كل فلسطيني بكدر يرجأ أبلده يرجأ، بس توسلوا بالسلامة ناكشوا موضوء سوا زي إنت ما كلت. الموضوء بدو جلسة أروء. هاي خطفة (خطوة) أمر (عُمر)." (ص65، ط 1، 2015)
حتى أن لودا هي من تطرحُ عليهما مكاناً ليعيشا فيه، فتدعوهما لـلعودة للإقامة في حيفا، في آخر الصفحة يقول المدهون:
"اختارت لهما حيفا مكان إقامةٍ يعيشون فيه جيرانا: "تآلو أ خيفا؟". وحلفت يمينياً لا لزوم له، بأن المدينة "بتجنن، وبتاخد أكل (عقل)؟". (ص65، ط 1، 2015)
والأدهى من ذلك، هو محاولة الإيحاء بأن تمسك الفلسطيني في فلسطين 1948 بالبقاء، ما هو إلا تمسك مادي يعود الفضلُ فيه لأسباب وفرتها له حكومة دولة الاحتلال من قبيل الصحة والتعليم..إلخ:
تقولُ "جنين" رافضةً لمقترح باسم الذي يُلح عليها بترك مسقط رأسها في يافا والذهاب معه للعيش في بيت لحم:
"روء بسومتي روء، وما اتجننيش معاك. يمكن ترتاح لعيشتك عند أهلك ببيت لحم، بس أني بخسر عيشتي كلها ومعها كل إشي اتحصلت عليه بعرق جبيني من اسنين: الصحة والطبابة والتأمين الاجتماعي كله." (ص90، ط 1، 2015)
إمكانية العيش المشترك
لمجرد اختيار الكاتب لـلبريطانية جولي لتكون بطلة الرواية إلى جانب زوجها وليد، يكون قد مرر لنا فكرة أنه بالإمكان أن نتعايش مع المُحتل ومع المغتصب لأرضنا.
يبدأ المدهون بتمرير مجموعة من الأحداث التي بُنيت عليها الرواية من قبيل أن والدة جولي تزوجت الضابط البريطاني زمن الانتداب البريطاني على فلسطين، وأنها قد وقعت في حبه، وأنها لم تفكر للحظة في جنون علاقتها به. (ص29، ط1، 2015)
بالنسبة للمدهون هذا الحب طبيعي، وعادي، وقابلٌ للحدوث، وأنه بالإمكان أن يستمر ويعيش، وأن ما من شيء يهدده حتى وإن كان هذا الحب على حساب حب الوطن، فكما تقول والدة جولي:
"نظرة من زرقة عيني جولي التي تشبه عيني زوجها الضابط الميت تعوضها عن زرقة سماء عكا كلها، وأنها منذ عشقته لم يعد "جون"، في نظرها، بريطانيا مستعمراً كريها (...) ولقد كانت مستعدة لأن تفعل أي شيء لكي ترتبط بجون إلى الأبد، حتى لو اندلعت حرب كبرى بين بريطانيا العظمى وساحة عبود، وتورط فيها أرمن عكا كلهم". (ص29، ط1، 2015).
وعلاقة التعايش مع الاحتلال ممكنة، كما يسردها المدهون، حين يكون الصديق الأعز لوليد متزوجاً من اليهودية لودا أو لودميلا، وحين تكون جارة "باقي هناك" هي اليهودية أفيفا التي كان يُعرّب "باقي هناك" اسمها ويناديها ربيعة، ويأسفُ لحالتها:
"مسكينة ربيعة ماحدش سائل عنها أو عليها، لا جوزها ولا أولادها لثنين، والدولة بتبيع مأساتها ومأساة غيرها بالجملة وبالمفرق." (ص 79، ط1، 2015) أما زوج إفيفا فهو شاؤول شامير العسكري المتقاعد جار "باقي هناك"، وهو الذي شارك في 4 حروب ضد العرب، وأكمل سنواته في خدمة الاحتياط. (ص 148، ط1، 2015)
وحين تكون جارة "باسم" هي اليهودية "بات- تسيون" يغير اسمها "باسم" ليصبح "بات- شالوم" أي بنت السلام فمن "بنت صهيون" إلى "بنت السلام". (ص 74، ط1، 2015)
ويرمي لنا المدهون بفكرة أن الإسرائيلية قد أحبت هذا الإسم، للتدليل أن الإسرائيليين محبون للسلام، فيقول:
"وكانت بت –شالوم، حين لا ترى باسم أو جنين، أو يمر بها أحدهما ولو ليومين، تنادي على نفسها وتداعبها: "يااللا بت- شالوم" جزهي غداكِ بت- شالوم... وكانت تطرب لما تسمعه، وتصدقه كأنه حقيقة." (ص 74، ط1، 2015)
وعند زيارة وليد وجولي لمنزل عائلة وليد الذي كان يقيم فيه، ووجدوا أن إسرائيلية، تدعى رومه، وهي من الناجين من الهولوكوست، تعيش فيه، لم يكن المشهد درامياً، أو مفاجئا بالنسبة لوليد وجولي، بل كان فيه من الحميمية، والعلاقة الطيبة ما يُفاجئ، يقول المدهون:
"في المجدل عسقلان، تآلفت جولي مع رومة، سرا وعلانية، منذ لحظة (اتفدلوا) حتى (مأ سلامة). تصرفت كأنها في زيارة إلى جارة قديمة. لم تتوقف طيلة وجود أربعتهم في البيت الذي كان لعائلة دهمان ذات يوم، عن التحدث مع رومة بشيء من مودة ظاهرة". (ص 64، ط1، 2015)
أما الحكاية الدخيلةُ، التي لا هدف من وراء إقحامها في الرواية سوى الترويج لإمكانية العيش المشترك فهي قصة المثلي "سمير بدران" الفلسطيني الذي هرب من عائلته في بيت لحم ليعيش مع صديقه الإسرائيلي "حاييم عنباري" عضو فريق "تسفع إحاد" الغنائي الأشهر. (ص72، ط1، 2015)
ويُردِف المدهون على لسان "جنين" في أسطر لاحقة: "هذا الموقع وحّد المثليين في لبلاد، واهل لبلاد مش لاقيين مين يوحدهم." (ص72، ط1، 2015)
هكذا ببساطة، بإمكان المثليين أن يعيشوا معاً، بينما أهل البلاد،- وهنا إشارة لاعتبار الإسرائيليين أهلاً لفلسطين،- لم يستطيعوا مع أهل البلاد الآخرين وهم الفلسطينيين العيش سوية، فيصيرُ المثليُ سوياً، والسوي غير قادرٍ على التصرف بعقلانية.
وحتى حين تنتهي مأساة "سمير بدران" بمقتله، ويتم العثور على جثتة ملقاة في أحد شوارع رام الله، فإن عائلة "بدران" ترفض تسلم جثَّته ليس لأنه عاش مع إسرائيلي مثلي، ولكنها تبرأت منه لأنه هرب من المنزل. (ص76، ط1، 2015).
لغة تبرئ المحتل
عالم اللغة في الرواية ضعيفٌ في صوره، غني في مدلولاته التاريخية المغلوطة، التي تبرئ الاحتلال من احتلاله لأرضنا، وتنفي عن النكبة صفة القسرية والإجبار، وترى أن فلسطينيي عام 1948 هم منتمون لدولة الاحتلال.
ففي مقدمة الرواية يرى المدهون أن لدى الفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين 1948 "انتماء مزدوج" ص7، في محاولةٍ منه للترويج أنهم يتعايشون مع دولة الاحتلال، التي يعترفُ بها المدهون دولةً قائمة، خلقت واقعاً جديداً، هو دولة إسرائيل (ص 7). وما جرى من واقع جديد بسبب احتلال أرضنا في 48 لم يكن نتيجة تهجير وطرد بل كان نتيجة "هجرة السكان"، ونتيجة حرب بين طرفين أو بين جيشين كما يود المدهون تصوير الأمر (ص 7).
فاللاجئون الذين هُجروا من أرضهم، (بضم الهاء) لم يُهاجروا طواعيةً من أرضهم، ولم يكونوا في مهمة سفر، وإنما هُجِّروا قسراً من أرضهم، أرض أبائهم وأجدادهم، على خلاف ما تريد الرواية تصويره بأنهم مجرد سكانٍ "هاجروا" من بيوتهم أو "رحلوا" عنها.
يقول المدهون في الرواية: "أغلب ازلام عكا رحلوا عن المدينة سنة الثمانية وأربعين، واتغربوا وما نفعهم كل البوس اللي باسوه، ولا حتى حفلات الجنس الهستيرية التي سبقت الرحيل." (ص 17، ط 1، 2015)
وأن هذا "الرحيل"، لا يبدو في نظر الكاتب، كنتيجة لأحداث النكبة، التي لم يرد ذكرها إلا بالإشارة إليها عبر السنوات من قبيل القول عام 48، أو سنة ثمانية وأربعين، كما أشرنا في الاقتباس السابق، وفي مواقف أخرى في الرواية.
لغة القسرية، وفعل القهر والإجبار على إخراجنا من أرضنا بالقوة في عام 1948 تختفي من الرواية تماماً إلا في بعض المواقع التي يتم فيها استخدامها على استحياء واضح والذي له مدلولاته السردية.
يقول الكاتب إن عائلة لاؤور في عكا كانت "إحدى عائلات يهودية عدة، من لاجئي الإبادة النازية، سكنت المدينة القديمة التي هجرها سكانها آنذاك، تحت ضغط القصف المدفعي للمنظمات اليهودية الذي سبق احتلالها." (ص18، ط1، 2015)
خاتمة
ما ذكر أعلاه من أمثلة، ليس للحصر بل يأتي على سبيل الذكر، لأن الرواية حافلة بعشرات المشاهد التي تعزز الأفكار "المضللة" التي تحملها الرواية بين طيات أسطرها وبين لغتها وبين مضامين حكايات شخوصها.
وتظل هناك جوانب أخرى في الرواية أشرنا لبعض منها، والرواية مليئة بالجوانب التي يجب الاشتغال عليها من قبيل ما أشرنا إليه ولم نتناوله فيما كتبنا.
كم كان مؤسفاً أن يجمع الكاتب، الضحية والجلاد، على قدم المساواة، في حكاية الظلم الذي وقع علينا ويحاول المدهون الإيحاء بأنه وقع على محتلنا أيضا، تلك روايةٌ مشوهةٌ للتاريخ، ولتاريخ نكبتنا، ولتقرير مصيرنا.
هي روايةٌ، يجب أن تُقرأ بروية في الأبعاد والدلالات والإيحاءات التي يجهد الكاتب في إيصالها وتمريرها لنا، يجب أن تُقرأ جيداً قبل الاندفاع بالاحتفاء بها كفلسطينيين، لأنها لا تحكي عنا، إلا بطريقة مجتزأةٍ تخدم ما يرمي إليه كاتبها.
