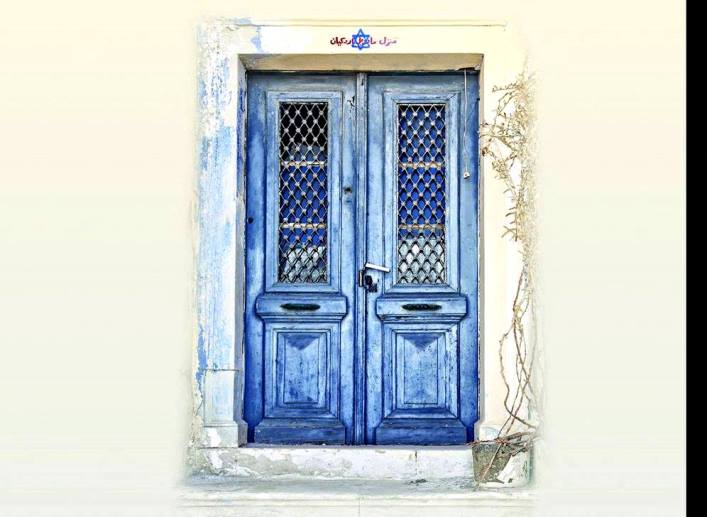
بقلم: وليد أبو بكر
1ـ كونشرتو الهولوكوست
في رواية ربعي المدهون "مصائر ـ كونشرتو الهولوكوست والنكبة" (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت: 2015) يبدأ التثاقف من العنوان ذاته، ثم يمتدّ إلى بقية النص، ولا ينتهي إلا عند السيرة المختصرة للكاتب، قبل الغلاف الأخير، حين يظنّ أنه يخلق لنفسه هيبة من نوع ما، وهو يسجل أنه "يحمل الجنسية البريطانية"!
إن في إضافة عنوان فرعي يحمل صفة "كونشرتو" محاولة ساذجة للإيحاء بأن الكاتب ضليع بالموسيقى، وكأن ذلك يميزه كاتبا. وعند قراءة الرواية، فإن القارئ لا يشعر بأية علاقة بين "الشكل" الذي يتخذه النص، والنوع الموسيقيّ الذي حمّل في العنوان. لكن الكاتب لا يكتفي بأن يختلق لعنوانه جوّا غريبا عنه، وإنما يعيد بعد ذلك تنويع تثاقفه من خلال "توجيه" القارئ إلى طريقة محدّدة في التعامل مع الرواية، وذلك عن طريق مقدمة لا لزوم لها، تتكرّم على القارئ بأن تعلّمه كيف يقرأ، وكأن صاحبها يقول إن الرواية فوق مستوى الآخرين، وإن من واجبه أن يقرّبها من فهمهم بأن "يشرح" لهم طريقة التواصل معها، حتى يوهم من له علاقة بأنه يقدّم نصا استثنائيا، قراءته ليست في متناول اليد، وفي ذلك حيلة غير ذكية على الإطلاق.
والنص ليس استثنائيا بالطبع، فهو مجرّد رحلة سياحية معادة، لا تختلف في أسلوبها ولا في مضمونها عن الرحلة السابقة للكاتب ذاته، في روايته السابقة اليتيمة، "السيدة من تل أبيب"، التي افتتحت مشروعه الروائي (بعد سنّ السبعين، كما تشير السيرة)، إلا بتوسيع أماكن الزيارة، فبدلا من غزّة، تسير الرحلة السياحية هذه المرة إلى عدد من مدن فلسطين (عكا، يافا، القدس، حيفا، اللد، الرملة)، لتكرر التأكيد على "أهدافها" التي كانت في العمل السابق مشبوهة، وسوف تزداد سوءا في هذا العمل.
ولعل من اللحظات الصادقة القليلة، غير المتكلفة، في العمل، أن الكاتب يعترف منذ البداية بأن "الصنعة" هي التي قادت عمله؛ فهو في مقدمته الزائدة عن الحاجة تماما، يعترف بأن العمل على النصّ كان صعبا لأن الأحداث "تجري في ستّ مدن فلسطينية لم أُقِمْ في أيّ منها" (ص 8)، ما يتناقض مع "المكان الحميم" الذي يستطيع الكاتب أن يستثمر شعريته حين يكتب، بسبب معرفته الدقيقة به، وارتباطه الوجداني، لا السياحيّ، وهو ما لا يستطيع جهد الآخرين الذين تتمّ الاستعانة بهم أن يجعله ممكنا.
ويعلن الكاتب صراحة قبل ذلك عن أنه أقدم على "توليف" النصّ في "قالب" الكونشرتو الموسيقي (ص 7)، أما عند الكتابة، فهناك وضوح في ما يرد على لسان وليد دهمان، الشخصية الرئيسية في روايتي المدهون الوحيدتين، حين يتساءل، في دعاية صريحة ـ تثاقفية نرجسية غريبة وصادمة ـ للكاتب داخل نصه: "هل أساله (أي الكاتب المدهون) عن مصيري في روايته "السيدة من تل أبيب" التي جعلني بطلا لها، وكتّبني رواية أخرى خلقت أنا أبطالها وصنعت أحداثها؟" (ص 167). إن كل ما في معاني "توليف" وقالب"، و"صنعت" يوحي تماما بمعنى القصدية المسبقة التي تناقض التلقائية في كتابة السرد، وهي تقود إلى تجلّي "التثاقف" بكلّ أشكاله بعد ذلك دون حدود.
في هذا التثاقف، أو التعالُم، استعلاء يبرز كلّ الوقت من خلال استعراض معارف أو "معلومات" يظنّ الكاتب أنه وحده يعرفها، وأن طرحها يوحي بالمصداقية، بينما هي في الواقع تفيض نرجسية عالية، تعلن عن نفسها باستمرار عبر الرواية، خصوصا وأن معظم هذه المعلومات معروف، أو موجود في كتب التاريخ، كما في أحداث كفر قاسم؛ أو الاحتلال الأول، أو الثاني لفلسطين، أو جائزة الدولة الإسرائيلية لإميل حبيبي؛ أو موجود في الجغرافيا، كما في أبعاد قبة الصخرة، وفي "التلة الفرنسية" التي تمّ التوصل إلى ارتفاعها ـ كما تشير الرواية ـ عن طريق البحث في غوغل (ص 96)، المتاح لكل قارئ؛ أو في كتب "فن الإتيكيت"، كما يحدث وهو يعلّم القارئ كيف يأكل بالشوكة والسكين! (ص105)؛ أو في كتب "فن الطبخ" في بعض الأحيان، كما في الحديث عن صناعة الكنافة النابلسية، أو عن المقلوبة، التي يعتبرها (كشخص كلّيّ المعرفة) غزّاوية بشكل حصريّ، وكأن بقية محافظات الوطن لا تعرفها! وغير ذلك كثير جدا لدرجة أنه لا يتوقف عن محاولته الحثيثة في تعليم القارئ اللغة العبرية، التي تبدو أثيرة لديه، من خلال الاستمتاع بترديدها (ص 108).
هذا "التثاقف" لا يعلن عن نفسه عند التعبيرات السانحة فقط، ولكنه ينسحب على كل شيء في الرواية، بتصميم شامل، ويبرز في تفاصيل فقراتها، بإصرار شديد، ما يجعل من الممكن أن يصنف على شكل "فئات" تثاقفية، لكلّ منها حضورها الأساسيّ، وتفرّعاتها العامة، وانعكاساتها على الفكر الذي تروّج له الرواية، بافتعال تثاقفي أيضا، وهو الفكر الذي يدور حول "التعايش" الذي لا مفرّ منه، مع المحتلّ، واعتباره ممكنا، بالشكل الذي اقترحته طفولة يسارية فلسطينية قبل عدة عقود، قبل أن تحتكّ منظمة التحرير الفلسطينية، والواقع الفلسطيني، خصوصا بعد أوسلو، بهذا الاحتلال بشكل مباشر، وتتعرّف على طبيعته الاستيطانية، التي تصرّ على امتلاك الأرض دون سكانها؛ وقبل أن يدرك الفلسطيني جيدا أن التعايش المطروح، من وجهة نظر الاحتلال، حتى في أوساط من يظن بهم التفاؤل داخله، لا يعني أي شيء يختلف عن التمييز العنصري، الذي يتمّ تطبيقه عن طريق استعباد شعب آخر.
"التوجه التعايشي"، أو التطبيعي الصريح، سبق للكاتب أن طرحه في روايته السابقة، وهو لم يأت في روايته الحالية بجديد، إلا محاولة أن يقول ما هو مباشر في وصف ممارسات الاحتلال، دون أن يقول السياق العام لروايته ما يوازي ذلك. ويبدو أن الكاتب لم "يتعلّم" من تجربته خلال الزيارات التي قام بها، ولا خلال الدعوات التي لبّاها، واعتبرها تكريما لذاته المبدعة، مع أنها جاءته من جهات يثور كثير من الأسئلة حول ارتباطها بذلك التوجه القديم، الذي ثبت فشله، ولم يعد مطروحا إلا بحجم الفائدة الذاتية لمن يتبنونه.
إن التعايش المقترح في الرواية لا ينتهي إلا عند أبواب التطبيع، حتى وإن تصور الكاتب أنه قد يفيده في ترويج ما يكتب، وظنّ أنه يطرح نفسه ـ للغرب على وجه التحديد ـ مؤمنا بذلك، ربما بافتعال سوف يشعر به الغربيّ دون عوائق، إذا أتيح له أن يقرأ.
2. في أشكال التثاقف
كثيرة هي الأشكال التي يتجسد فيها التثاقف في رواية "مصائر ـ كونشرتو"، حتى بين ما هو عابر من تفاصيلها، فالكاتب مثلا لا يعفي أسماء بعض شخصياته من ذلك: باق هناك (في تقليد لشخصية باقية في "متشائل" إميل حبيبي، وهو التقليد الذي ستكون له امتداداته)، وجنين وغزة وبيسان وفلسطين، مع ما يميز هذا النوع المستهلك من "الترميز" من سذاجة خالصة لا تستطيع أن تخفي أو تخدع.
كما أن هذا الافتعال يبرز في إقحام شخصيات يهودية دون مبرر؛ فليس هناك ما يدعو إلى التصريح بأن لودي الروسية، التي تنافست على حبها شخصيتان أساسيتان في الرواية، يهودية، مع أن نفي ذلك يأتي على لسانها منذ بداية التعارف، لأنها تعتبر نفسها شيوعية. وكثيرا ما يشعر القارئ بوصف زائد يهدف إلى طرح اسم يهوديّ يصرّ الكاتب على أنه "يُشعِر بالراحة"، كما في الطرح التثاقفي المقحم للشاعرة اليهودية ليا بورتمان، صديقة الأم الأرمنية العكاوية التي تفتتح الرواية بحضورها جلسة وصيتها، وبحكاية هروبها مع ضابط إنجليزي في فترة الانتداب (ص 23).
ثم يضاف إلى ذلك اهتمام خاص بشرح الطقوس اليهودية في بعض المناسبات، مثل أن "دفع النقود أو تلقيها في عطلة السبت، يعدان خطيئة عند المتدينين اليهود" (ص 63)، ولا يستثنى من هذه الطقوس، لدى الكاتب، ما يشكل دعما لحقّ اليهود الإلهي الذي يدّعونه في أرض فلسطين: إن وليد دهمان ـ مثلا ـ يمازح حماته العكاوية البريطانية، بما هو خارج عن سياق الأحداث، بعد أن تنتهي من توضيح وصيتها، فيقول، "بينما كؤوس الجميع معلقة في الهواء: أتعرفين أن اليهود يعتقدون بأن من تدفن جثته في تلك البلاد، يكون أول من يبعث حيا ويكون في مقدمة طابور المنتظرين على باب الجنة يوم القيامة." (ص 35)، دون أن يكون في هذا "المزاح" شيء من المزاح، أو ما يبرر أن يقال أصلا. وفي مثل هذا القول نفاق هدفه أن يرضي الغرب بمثل هذا الطرح الذي لا مناسبة لوروده، كما أن فيه ادعاء من الكاتب بأنه يملك ثقافة حول هذا الموضوع، فهو يعرف "طقوس اليهود"، حتى وإن لم تكن لسرد هذه المعرفة صلة بسيرورة الرواية.
ويمكن القول إن التثاقف الذي تزدحم به الرواية ينسحب على محاولات كثيرة للتنبؤ بما سيأتي من أحداث، وعلى تخيل ما يفكر فيه الآخرون، ثم على مراكمة أسماء المطربين الأجانب، وأغانيهم، والكتّاب، وكتبهم، إلى الحدّ الذي يجري فيه ما يشبه التلخيص لإحدى روايات أهداف سويف، وإلى حد ما لرواية المتشائل.
كل هذا التثاقف يوقع الرواية في أخطاء فنية وفكرية، تكاد تجرّدها من الالتزام بفن الرواية، والاكتفاء بسرد الرحلة السياحية المبسطة في بعض المدن الفلسطينية المستباحة، مع الترويج السياحيّ الذي لا منطق فيه، للأفكار المسبقة.
2 ـ 1: في باب اللغة
مع أن الرواية مكتوبة باللغة العربية، إلا أن هذه اللغة ذاتها متلوّنة ويجري تطويعها لتناسب ما يطرحه الكاتب من أفكار، أو لتشكل أداة لهذه الأفكار بشكل ما. لذلك تبدو لغة الرواية بكاملها مفتعلة تماما، ما يمكن أن يلاحظ في معظم الاقتباسات التي سترد لاحقا.
وتكون هذه اللغة مرة فصيحة (مع حضور كمّ لا يستهان به من الأخطاء)؛ ثم تكون مرّة أخرى عامية، وغير متقنة، لأنها تخلط اللهجات، فتجعل لهجة يافا غزاوية على سبيل المثال؛ وفي مرة ثالثة تتحوّل إلى لغة "مكسّرة"، كما يحلو للكاتب أن يتصور أن الأجانب يلفظونها. وإذا كان من المقبول أن تستخدم العامية في الحوار، رغم أن الكاتب لا يلتزم بذلك، إلا أن استخدامها في السرد يبدو غريبا في بعض الأحيان، كما أن استخدام "اللغة المكسّرة" يثير السخرية وهو يذكر بالطريقة الساذجة في بعض الأفلام العربية القديمة، التي غالبا ما تميل إلى الكوميديا، حين كانت تقدم شخصية من "الخواجات"، مع أن "التكسير" هناك يمكن أن يكون مقبولا، لأنه يقدم صوتيا، ما يفتح مجالا للضحك، بينما يقدم في الرواية مكتوبا، ليفتح مجالا للسخرية من الأسلوب، خصوصا وأن تثاقف الكاتب يتدخل بين حين وآخر، ليضع بن قوسين ما تعنيه اللفظة التي تنطق بها شخصية من أصل أجنبي، باعتباره خبيرا في كل شيء.
والأصل الأجنبي لبعض الشخصيات، الذي هو جزء من التركيبة المصنوعة للرواية، ربما كان وراءه هدفان: الأول هو التثاقف عن طريق اللغات، والثاني هو طرح الأفكار، التي توحي بأنها أممية. وفي مجال اللغات، يستخدم الكاتب أربع لغات أخرى (غير العربية وتفرّعاتها) داخل الرواية، ليوحي للقارئ بأنه يتقن هذه اللغات جميعا، وكأن ذلك ـ حتى لو كان حقيقيا ـ يزكّي كتابته، مع أن بعض مشاهد هذه الكتابة كانت تفتعل، بهدف ظاهر، هو التحدث بواحدة من هذه اللغات الخمس.
من هذه اللغات، الإنجليزية، وهي لغة جولي، زوجة وليد دهمان، السارد البطل في الرواية، والتي تزور البلاد معه، وتعشق عكا، مسقط رأس والدتها، وتفكر بأن تعود لتعيش فيها، بينما لا يبدي الزوج الفلسطينيّ المهجَّر أي اهتمام بمقترح العودة، بل ويوحي بأن زوجته نسيته بمجرد وصولها المطار، منهية رحلتها السياحية.
وقد استخدم الكاتب الإنجليزية كثيرا، بحروفها الأصلية حينا، ومكتوبة بالحرف العربي حينا آخر، وحين فعل، لم يتأخر في شرح المعنى، مثل المعلّم الشاطر، وهو ما فعله في اللغات الأخرى التي يتثاقف بها داخل الرواية، دون أن تضيف إليها شيئا من التميز، مثل اللغة الروسية، لغة المرأة التي أحبّها الصديقان (وليد وجميل)، فشكلوا معا "ترويكا" أهم من تلك التي كانت تتسيد الكرملين باسم دكتاتورية البروليتاريا" (ص 186)، وتزوّجها جميل، لتكون معه في استقبال صديقه، حتى تتمّ زيارة حيفا، ويدور الحديث بالروسية وحسب.
وكان على الكاتب ـ بالطبع ـ أن يبرّر وجود هذه المرأة في الرواية، وأسباب استخدام الأصدقاء الثلاثة لغتها، فافتعل أحداثا تخصّ دورة في موسكو (لمدة عام، في الكوادر الحزبية، كانت كافية للحبّ، والتنافس، والزواج، وتعلّم اللغة إلى درجة استخدامها في الكتابة الأدبية). ووردت هذه الأحداث مقحمة في وقت مستقطع خلال رحلة الأصدقاء إلى حيفا، عروس الكرمل، بالطبع.
أما الفرنسية، فقد جاءت لغة عابرة في بعض الأوقات، واستخدمت من باب تقليد بعض كبار الكتاب الذين يمرون بها في كلمات متداولة، تشكل جزءا من ثقافة إحدى طبقات مجتمعهم في العصر الذي يعيشون فيه، كما يفعل تولستوي مثلا في روايته الشهيرة "أنّا كارينينا".
لكن اللغة الثانية، من ناحية حجم الاستخدام في الرواية، ومن حيث الاهتمام الشديد بتقديمها، هي اللغة العبرية، التي يجري الكاتب بعض المقارنة بينها وبين العربية، ليشير إلى التشابه الذي يعني بكل بساطة أنهما لغتان شقيقتان، تنتميان بالتالي إلى شعبين شقيقين، يمكنهما أن يتعايشا معا، وهو الطرح "السياسي" الذي تحاول الرواية بمجملها أن تتقدم به.
ومن الواضح أن استخدام هذه اللغات لا يفيد الفنّ الروائي في شيء، سوى المزيد من التطويل، وإذا تجاوزنا التثاقف عن طريق إيراد بعض الأغاني بلغتها الإنجليزية، فإن كلّ كلمة وردت بلغة غير العربية، جرت ترجمتها، ما يعني أن وجود اللغة الأخرى لم يكن ضروريا، لا في الفن ولا في المعنى، إلا بقدر ما يقتضيه التثاقف الذي يسود الرواية كلها، ويجعل كل ما فيها متكلفا.
والتكلف انعكس على الصياغة اللغوية في الرواية أيضا، حتى إنه يمكن القول إن لغتها تفتقر إلى الحساسية التي يحتاج إليها السرد الروائي. ولعل الأوصاف والشروح والتركيبات الغريبة التي ترد في الرواية تعطي فكرة عن هذا التكلف، وهي مما يصعب حصره بسبب كثرتها، وكأن الكاتب يتصوّر فيها نوعا من البلاغة، مع أنها تتسم بنشوز لا يليق بالسرد، لأنها تبتذله: فحين يصف الكاتب اليوم الصيفي بأنه "دافئ استوردت بريطانيا شمسه من الهند" (ص 36)، فإن الاستغراب لا بدّ وأن يصيب القارئ الواعي وهو يتساءل: ما الذي أدخل هذا في ذلك، سوى التثاقف؟
مثل هذا النوع من التعبير يتكرر كثيرا، ليوحي بأن الكاتب يتقصده؛ فحين تتحدث الأم ـ في الهاتف ـ عن دهون أبو فاس، تعلّق: مش الفاس اللي بنكشو فيها الأرظ، لأ يمه.. أبو فاس اللي بيدهنو فيه رجليهم عشان الروماتيزم" (ص 62)، ومن الغريب أن الأم التي تتحدث بلهجة عامية خالصة، تستطيع أن تلفظ الاسم الصعب للمرض، دون خلل.
لقد ألحّت جولي على أن الوقت قد حان "ليستعيد رأسها مسقطه. مع أن رأسها "سقط" في قاعدة عسكرية بريطانية، ولم تهبط من رحم أمها في ساحة عبود" (ص 48)؛ والباب القديم "توزّعته ثقوب كما تتوزع المستوطنات اليهودية جغرافيا فلسطين" (ص 78)؛ كما أن باسم يعود "من جولته في اللد بينما الليل يستعد للسهر مع جنين" (ص 81)؛ أما أنفاس الزوج فهي تتردد من حول زوجته "هادئة مثل موج أتعبه صخب النهار" (ص 83)؛ ويبدو تفصيلا مضحكا أن تتمّ المفاجأة أن "باق هناك" عاد ـ إلى الوطن بعد هجرة شهرين ـ "ليتزوج أم جنين، التي لم تكن قد أصبحت أمّها بعد، ولا أُمّاً لأيّ من أخواتها الذين يكبرونها"! (109).
ومن السهل الإشارة إلى بعض النماذج السريعة الأخرى، لمثل هذه التراكيب الغريبة: بيت (عربي طبعا) تشبه واجهته الملتصقة به على الرغم منه، نصف نعل مهترئ (ص 56)، ورجل نحيف إلى حافة السمنة (ص 126)، وجنين وضعت كأسها على طاولة تلامس حافتها مؤخرتها (ص 128)؛ ورشفت ما تبقى من فنجان قهوتها ولم تبقِ شيئا لقراءته (مع عدم وجود من يفكر أصلا بقراءة الفنجان، فهو كلام مجاني) (ص 129)؛ حتى إنه لم يتثاءب، ظنا منه أنه قد يدفع ثمن ذلك (ص 141)؛ رمى نفسه على المقعد المقابل لنا بطريقة ستعاتبه مؤخرته عليها (ص 163)؛ بدا معها جدلهم مثل سلطة كلام بألفاظ حارقة (ص 237). وإذا كان بعض هذه النماذج قد يبدو مقبولا، فإن وقعه في سياقة لا يحتمل.
وهذا التكلف يهيئ لبعض السقطات اللغوية التي تفلت من "الصنعة" مهما كانت محكمة، ولذلك فإن جنين مثلا قرأت رسالة من مجهول "قفزًا بين سطورها، تلمّ منها المعاني على عجل، ثم أعادت قراءتها، مفصلة، عشرات المرات حتى حفظتها"، وكل ذلك يوحي بأن الرسالة تتسم بكثير من الإطالة، ليفاجأ القارئ بأنها "لا تزيد على ثلاثة سطور"! (ص 102).
كما أن القارئ لا يستطيع إلا أن يقف مستغربا أمام بعض الاشتقاقات اللغوية الغريبة التي يستخدمها الكاتب، وفي ظنه أنه "يخترع" جديدا في اللغة، دون أن يدرك أن الجديد في اللغة لا تقبله الذائقة حين يكون منفرا، أو غير فصيح، لأن التنافر يقع بين حروفه، مثل كثير مما استخدم، على طريقته في "الأَمْأَمَة" أو "الأوأوة" وما يجري مجراهما.
2ـ2: باب المعرفة
عندما يرغب الكاتب في أن يزجّ بكل هذا الزخم من المعلومات غير الضرورية في عمل واحد، فإن الوقوع في الخطأ لا يكون أمرا طارئا. وفي الكونشرتو مجموعة من الأخطاء التي تؤكد أن كثيرا مما قيل عن الأبحاث والاستشارات لم يكن إلا من باب التثاقف، أو بثّ الثقة في نصّ يفتقر إلى الثقة، لأنه يفتقر إلى البحث الجاد، وتغيب عنه الاستشارة والتدقيق، في أمور تكاد تنسب إلى المعرفة الأولية العامة.
إن القارئ يستطيع أن يشكك تماما في أن الأسماء الكثيرة التي قدم لها الشكر في مقدمته التوجيهية "قبل القراءة"، لا يعرف أحد منها أن الشهيد مصطفى علي الزبري هو نفسه أبو علي مصطفى، قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي اغتاله الاحتلال بصاروخ داخل مكتبه (ولا داع هنا للتفصيل التثاقفي، فالحادثة مشهورة). وإذا كانت هذه المعلومة الحديثة والمهمة، والتي كان لها صدى كبير، وردود فعل واسعة، تغيب عن الكاتب وشهوده الذين شكرهم، فإن المنطق الفلسطيني في التسميات يشير إلى ذلك: فأبو علي يعني في الغالب أن اسم والده هو علي، كما هي العادة في التسمية، ومصطفى هو الاسم الصريح للشهيد، ليكون مصطفى علي، أما الزبري فهي عائلته (وللتثاقف يقال إنها معروفة في بلدة عرّابة القريبة من جنين، التي حملت إحدى شخصيات الرواية اسمها). لكن الكاتب، مع شهوده الكثيرين، ومستشاريه، وبحوثه، استطاع أن يحول الشهيد الواحد إلى اثنين في نهاية قائمة شهداء (تثاقفية) يقدمها: "... أيمن حلاوة، مصطفى علي الزبري، أبو علي مصطفى..." (ص246).
وليس هذا هو الخطأ الوحيد الذي يقع فيه الكاتب نتيجة عملية التثاقف التي تسود روايته، فلعل من السهل مثلا مناقشة موضوع السفر المنفرد للزوجين اللذين يحملان الجنسية الأمريكية (باسم وجنين)، كل في طريق، لأن مثل هذا التفريق مفتعل، ما داما قادرين على الوصول من أي مطار يشاءان، بقدرة الجنسية التي يحملانها. والكاتب نفسه، ممثلا ببطل روايتيه اليتيمتين، دخل ما يسميها "البلاد" ـ ويعني فلسطين ـ غير مرة من المطار الذي نسميه نحن مطار اللد، ويسميه الكاتب مطار "بن غوريون" في اللد (ص 48 مثلا)، ربما تيمنا بالمؤسس، أو لدمج الاسمين معا (كاسم واحد لشعب واحد مثلا). لماذا تعود الزوجة ـ كالعادة ـ عبر مطار بن غوريون في اللد، ويعود الزوج من مطار عمان، ليحكم عليهما بالسفر منفصلين في كل مرة يغادران فيها البلاد، والعودة إليها منفردين كأنهما "زوجان تراجعا عن طلاق مؤقّت أجبرا عليه"؟ إن الجملة الوصفية التثاقفية الزائدة في النهاية هي الهدف، من أجل خلق شيء من التراجيديا الساذجة وحسب، وهي بالضبط ذات التراجيديا المتكلفة التي لا تسمح للأمريكي بأن يعمل في إسرائيل.
قد يكون التحفظ الوحيد الذي يمكن أن يواجه الزوج في موضوع المطار هو أن يكون حاملا للهوية الفلسطينية، وهو أمر غير واضح في الرواية، كما أنه لا يمنع الزوجة ـ منطقيا ـ من أن تتلافى الانفصال السفريّ المأساوي، وتعود مع زوجها عبر مطار عمان، إلا إذا كانت ترى أن توحيد السفر مع الزوج لا يستحق عناء الجسر، وهو عناء لا يعرفه الكاتب البريطاني الجنسية بالطبع، فلا يرد في ذهنه.
ورغم منطقية هذه المعادلة، إلا أنها قد تكون خادعة، وتغيب عن القراءة العابرة، كما قد يغيب ربط إميل حبيبي ببيت الكرمة (ص 202)، رغم ما بينهما من تناقض فكريّ حادّ، يعرفه من يعرفهما دون ادعاء تثاقفي، لأن حبيبي مقاوم شرس، وبيت الكرمة جزء من المؤسسة الرسمية. وقد يغيب عن القارئ أيضا أن يفطن إلى أن 5ا سنة زواج مرّت على الفلسطيني (الذي يتمتع بصحة جيدة) ومع ذلك فإن ابنه الأكبر في الرابعة من عمره (ص 210)، كما قد يمرّ عليه أن الدرجات الكثيرة التي توصل ـ من شارع سليمان القانوني ـ إلى باب العامود "قليلة"، كما تصفها الرواية (ص 215)، رغم أنها ليست كذلك، بالإضافة إلى اتساعها الكبير، الذي يشعر من يجتازها صاعدا أو نازلا بهيبتها الفائضة التي توحي بالكثرة. وقد لا يفطن لحساب السنين في حياة زكريا، الذي قضى 30 سنة من العمل كمعلم في الكويت، وهو يعيش في كندا منذ سنوات يمكن حسابها ببساطة منذ حرب الخليج الأولى (التي هجّرته إلى كندا) حتى الزيارة الميمونة لبطل الرواية وليد دهمان، قبل سنوات قليلة، يمكن حسابها أيضا، ومع ذلك فهو ما يزال "في بداية العقد السادس من عمره" (ص 126)، كما تؤكد الرواية، ورغم مأساة النزوح المتكرر، ما يزال يتمتع بحيوية شاب في الثلاثين! لكن هناك أمورا أخرى لا يمكن التجاوز عنها، ولا يمكن أن تفوت على القارئ، لأنها تقلب الجغرافيا حينا، وتغير التاريخ الحقيقيّ المعروف جيدا، حينا آخر.
في الجغرافيا، أبواب القدس معروفة لمن يرغب في المعرفة (ولا ضرورة لتعدادها تثاقفيا، لأن الوصول إليها سهل)، فهل يوجد بين هذه الأبواب ما يسمى "باب الواد"، (لا شارع باب الواد، أو طريق باب الواد)، حتى يقول الكاتب: "تابعت طريقي في الجهة الأخرى عبر باب الواد وغادرت المنطقة من باب العامود إلى موقف السيارات؟" (ص 229). إن باب الواد، دون تحديد اسمه كشارع أو طريق، في الجغرافيا المعروفة للجميع، منطقة لا تتبع القدس ـ المدينة، وهي بعيدة عنها، فهي المكان الذي يبدأ الطريق إلى الساحل الفلسطيني، بعد الخروج من المدينة وما حولها، والهبوط من الهضاب التي تشكلها، إلى واد يحمل هذا الاسم. كما أنها منطقة معروفة أيضا، لأنها في التاريخ شهدت أهمّ معركة دارت حول القدس زمن النكبة، بين الجيش الأردني والإسرائيليين، وما زالت بعض الدبابات التي أعطبت خلالها موجودة في مكانها، يراها كل من يتوجه لزيارة القدس، عبر ذلك الاتجاه، الذي سارت فيه الرحلة الميمونة للرواية، ويلاحظ أنه تتمّ العناية بها باستمرار، كما ينتصب فيها قبر أحد شهداء المعركة.
لكن أغرب ما يمكن أن يقع فيه كاتب فلسطيني، وتقع فيها معرفته، وأبحاثه، وجهود من استشارهم، هو ما رواه عن عزّ الدين القسام، قائد الثورة الريفية في فلسطين (للتثاقف: أواخر 1935)، لأن كثرة الكتابات عن ثورة القسام لا تترك مجالا للخطأ في أساسياتها: لقد قامت الثورة في أحراش بلدة يعبد، واستشهد القسام وبعض رفاقه هناك، ثم أجريت جنازته في حيفا، حيث دفن في مقبرة تحمل اسمه حتى الآن، تقع في "بلد الشيخ" المهجّرة، الملاصقة لحيفا، والتي كانت سكنا مفضلا لريفيي فلسطين الذين كانوا يعملون في حيفا، قبل النكبة.
رواية الكونشرتو ـ الدقيقة في معلوماتها ـ تحيل هذه الوقائع إلى نقيضها تماما، ففيها تكمل أم جميل حكايتها، بعد أن تتحدث عن ابنة القسام، قائلة عن الشيخ الشهيد، بكل ثقة تنطلق من تثاقف الكاتب: "يا حرام قتلوه وجابوه بالكارّة، العربانة اللي بجرها حمار ابعيد عن السامعين، وأخذوه ع يعبد، وهناك قبروه. قتلوه للقسام بحيفا وشفت بعينيّ جثته امّددة على الكارة، وقتها كل حيفا سكّرت" (ص 206 ).
ولأن الكاتب بعيد عن فلسطين ـ إلا فيما يخصه ـ متخفّ خلف بريطانيته، فهو لم يسمع قط بما أصاب المقبرة من انتهاك أقدم عليه الاحتلال غير مرة، بالتجريف، ولم يعرف أن مجرد وجود قبر القسام ذاته يقلق الاحتلال، ولم يسمع بردود الفعل التي حدثت تجاه ذلك، لأنه مكتف بما يعرف، مع أن كل هذه المعلومات متوفرة عبر صديقه "غوغل"، وتستحقّ البحث والتدقيق أكثر بكثير من البحث غير الضروري عن الارتفاعات في التلة الفرنسية.
3ـ في ما لا يلزم
استخدم الكاتب مثل هذا التعبير في الوصف عدة مرات، لكنه لم يلتزم به في كتابته، فالحرص، المرضيّ إلى حدّ كبير، على ضخّ المعلومات التثاقفية في العمل الروائي، لا يشقّ طريقه دون أن يمرّ بمجموعة من العثرات، غير تلك التي سبقت الإشارة إليها. هذا الحرص ـ إذا استعرنا طريقة الكاتب في الوصف التهكميّ ـ يبدو مثل تكرار البخيل عدّ ما يملك من مال، تعبيرا عن الإحساس الذاتي بالملكية الخاصة، تستدعيه النرجسية كثيرا، حتى تستعرض ما لديها. لذلك فإن هذه كمية الكلام، الزائدة عن الحاجة، التي تبث عبر الرواية، تكاد تستغرق معظم نصها، وهي تشكل جزءا من سماتها الأساسية، سواء أجاءت على شكل تكرار للمعلومات أو المشاهد، يتسم بالملل الذي لا يضيف شيئا، أو على شكل لا مبرّر لوجوده من الأساس، لأنه لا يخرج عن كونه مجرّد ثرثرة لفظية، غالبا ما تجيء لأن خاطرة تستدعي خاطرة، فيحلو الحديث عنها. ولأن السمتين تغطيان النص بكامله، سيكون من الصعب حصرهما، ولذلك سيتم الاكتفاء ببعض ما ورد منهما.
3 ـ 1: باب الزيادة
وهو ما يعني أن ما يمكن اختصاره من النص يشكل نسبة عالية جدا، دون أن يتأثر ما يريد النص أن يوصله، لا من ناحية الأحداث التي يرويها، ولا من ناحية الأفكار التي يحملها، وهو يعني على وجه الدقة تحميل النص فوق طاقته، من خلال بعض التحايلات السردية التي تلوي عنقه حتى يستجيب لتفصيل غير ضروري، وليس من شأنه أيضا.
إن وضع أنواع السيارات التي تركبها الشخصيات، وسرد أسماء الفنادق والمقاهي التي ترتادها، دون أن يكون لذلك ما يبرره على المستوى الدرامي، شكل من الزيادات، ولكنه في الواقع أخفّها، وأقلها استعراضا؛ فهذا النوع من التفصيل يتحول إلى هاجس أمام كلّ مكان، وأمام كل حدث أيا كانت طبيعته، يجعل الكاتب يشرح منه ما هو معروف تماما، أو متاح للمعرفة، بما لا يشكل إضافة لقارئه، إلا في عدد الصفحات.
إن الزوجة تحمل الوعاء الخزفي الذي يحمل نصف رماد جثة والدتها لتلقيه في نهر التايمز، حسب وصيتها. وكان من الممكن وصف عملية إلقاء الرماد بشكل فني لا يضيق به القارئ. لكن الكاتب ـ كما هي عادته ـ وبعد أن تحدث عن الشركات التي تصنع الخزف الخاص برماد الموتى الخاصين، وسجل أسماءها وعناوينها، عمد إلى الوصف الاستعراضيّ الخارجي الذي لا علاقة له بحالة الشخصية، ولا بالقارئ بعد ذلك. لقد ذهبت جولي بصحبة زوجها إلى "ووترلو بريدج" وسط لندن. "وهناك توقفا قبل بلوغ وسط الجسر بأمتار قليلة، أقرب إلى الجهة المطلة على مبنى "رويال ناشيونال تياتر". كان المساء يقترب من ليله هادئا كسولا مثل نهر التايمز، لم يضايقه مطر ولم تغضبه رياح، وقد نعست على جانبيه زوارق كثيرة وغفت. وكانت منطقة "ساوث بانك"، أسفل الجسر، وعلى امتداد النهر حتى "ويستمنستر بريدج" خلفهما، مشغولة بتجوال كثيف متخالط، لرجال ونساء من جنسيات وأعمار مختلفة، يتبادلون سعادتهم أو أحزانهم الخاصة على ضفة النهر العريضة. بعضهم منفعل، وآخرون يطلقون ضحكا قصيرا خفيفا يشبه أزياءهم وله ألوان رغباتهم، بينما يمضون إلى سهرة تظللها مشاعر هادئة، ويمضي غيرهم نحو أوقات عارية من تحفظاتها، يستيقظون منها صباحا مندهشين من وجودهم في أسرّة غيرهم" (ص 39).
ومع ما لا يمكن القفز عنه من معرفة الكاتب لمشاعر الناس ونزواتهم، وما سيفعلونه خلال عريهم، يمكن القول إن مثل هذا التفصيل، في الموقع وما يدور حوله، لا علاقة له بالحدث الحقيقيّ في النص، وهو إلقاء الرماد فوق الماء. وهو بالتالي غير مرتبط بأي شيء يخصّ جولي وزوجها وأمها، وإنما هو من "فعل" الكاتب حتى يقول إنه يعرف المنطقة، وكأنه وحده يعرفها، وحتى يفتعل بعد ذلك موضوع وجود "فرقة موسيقية تعزف كونشرتو "دي أرانخويز" للإسباني خواكَن رودريغو" ـ يا للصدفة! ـ لتلقي الزوجة رماد أمها مع الحركة الثانية من الكونشرتو، تطويعا للعنوان المفتعل أساسا، وهو تطويع لا يفطن إليه الكاتب بعد ذلك، إلا في تحويل صفات فصول الرواية الأربعة إلى حركات.
إن "الفعل" الروائي الناجح لا يحاول أن يهرب من متابعة انفعالات الشخصيات الروائية بالحدث، ولا حتى بما حولها، مما يكون له تأثير على الحدث، ليتوجه إلى وصف ما هو خارج ذلك تماما؛ فما هو المنطق الذي يجعل القارئ يصدّق أن الكاتب ـ على لسان شخصية في روايته ـ عليم بأسرار الناس، وبما يفكرون به، وبما سيفعلونه بعد ذلك، مما سيدهشهم أنفسهم؟ وما علاقة كل هذا "الخروج" التثاقفي بالحدث الروائي وشخصياته؟
هناك كثير من المشاهد التي يضيفها الكاتب زائدة، من أجل ذاتها فقط، حتى من باب "الاستعادة". ومن ذلك مثلا وصفه للحمّام الذي استوقفه "وأوّهه فتأوه... واستعاد وليد تلك الزيارة المدهشة التي وقعت في أول يوم لهما في عكا، حين تركت جولي عمرها على الباب الإلكتروني بعد أن اجتازته إلى الداخل، وخلعت ملابسها في الغرفة الصيفية، كوّمتها على الأرض، وراحت تتأمل جسدها كما كانت تفعل في سنوات مراهقتها. وراح وليد يتأملها تلفّ منشفة قطنية حول جسدها، تطوي طرفيها العلويين وتشدّهما تحت إبطها. انتعلت قبقابا خشبيا، ومشت تلحق بها "طرقعات" القبقاب كأنها غوار الطوشة الذي لم تشاهده ولم تتعرّف عليه. تردد صدى صوت القبقاب في الغرفة ذات السقف العالي. خلعته من قدميها، وما زال صدى "طرقعته" يتردد في المكان. تمددت على وجهها على البلاط المبلل في "الغرفة الساخنة" واختفت في البخار، تاركة خلفها صرخة ناعمة لم يسمعها وليد: "دلّك لي جسمي كله يا وليد". كان غارقا في متابعة فيديو يعرض مشاهد تمثيلية مصورة لما كان عليه الحمام وطقوسه حتى وقوع النكبة" (ص 50ـ51).
إن ما يحدث داخل الحمام في العادة لا يرى، من وجهة نظر الراوي، حتى يقوم بوصفه، فالحمامات الشعبية لا تكون مختلطة، والنص لم يبرّر وجود الزوج في البداية كي يرى كيف تخلع زوجته ملابسها، ثم تلفّ المنشفة، كصورة من الأفلام القديمة أيضا، التي يبدو الكاتب متأثرا بها إلى درجة النقل، وهو ما يوحي به التشبيه بغوّار الطوشة، الذي لم تشاهده الزوجة ولم تتعرف عليه (فلا داعي لذكره إذن)، ما يعني أن المشهد كتب، من أجل المشهد ذاته، لا من أجل النص ككل.
وكثيرا ما يكون المشهد الذي تقدمه الرواية خارج سياقها تماما: فما هي وظيفة "الطهور" التي ترد داخل النص (ص 118ـ119) سوى التحدث عن "عادة" لا علاقة لها بالرواية؟ وما هي وظيفة توارد الخواطر في النص وهو ينتقل من وصف بيت الشرق في القدس إلى ذكريات عن المجنونة في بيت الراوي في غزة؟ وما علاقة القطار الذي ركبه الزوجان في باريس (ص 230) بالرواية، كي يقحم فيها، لأنه ورد على خاطر المؤلف؟ وفوق ذلك، ما علاقة النص بكامله بالحديث عما يجري في سجن بعيد، هو ليمان طرة المصري (ص 231)، حيث تقطع صخور جبلية لا حاجة لقطعها أصلا، سوى التقاط صورة أخرى من فيلم قديم، لا حاجة لها في الرواية أصلا؟
ولا يكون الزائد وصفا أو إضافة لمشهد "سينمائي" فقط، ولكنه قد يرد حتى في الحوار الذي يجري على ألسنة شخصيات الرواية، خصوصا حين تختلط فيه اللغات اختلاطا عجيبا، رغم أنه اختلاط مقصود بذاته، ولغرض سياسي غير خفيّ:
"البيت فيه غرباء يا جماعة."
هتفت فرحا بوجود غرباء في بيتنا: "في بيتنا يهود!"
"هئم يِش مي شهوو بَبايتْ؟"
سألت لودا إن كان في البيت أحد.
"مي؟"
سأل صوت نسائي متوجس "من؟"
"أني روتساه لِدَبير عِم مي شِبَبيت."
ردت قائلة إنها تريد أن تتحدث مع من في البيت. (ص 57).
من الواضح أن الهدف من مثل هذا الحوار، الذي يتكرر عبر الرواية، والذي كان من الأسهل والأنسب أن يأتي على شكل سرد، هو استخدام اللغة العبرية، الزائد تماما، خصوصا مع التفسير الذي يلحق بكل كلمة. من أجل ذلك ربما كانت شخصية لودا الروسية يهودية، وما يؤكده أن يهتف وليد دهمان بفرح "في بيتنا يهود"، ما يثير الاستغراب حول فرحه من ناحية، وما يذكر ـ من جديد ـ بحضور فيلم قديم أيضا، هو "في بيتنا رجل"، من ناحية أخرى، ليكون التأكيد على أن الأفلام القديمة جزء مهم من "ذخيرة" الكاتب، يستحق أن يستدعى؛ وليس في ذلك خطأ بالطبع، إذا استدعيت الصور في مكانها، وهو ما لا يفعله الكاتب.
3 ـ 2: باب التكرار
كثيرا ما لا يورد الكاتب أي مشهد أو حدث في النص مرة واحدة، فهو يعمد إلى تكرار المشاهد وسرد الأحداث بشكل بعيد عن العين الناقدة التي تراجع وتدقق، ما يوحي بالاستعجال الذي يلحق بمثل هذه الأعمال السياحية، حتى وإن ادعى كاتبها أنه عمل فيها أربع سنوات، لأن ما يهمّ القارئ هو نتاج هذه السنوات، لا عددها.
بعض هذه الأحداث يروى مرات عديدة، دون إضافة تستحقّ التكرار، كما هو الحال في وصية الأم بأن يدفن رمادها في بيتها بعكا، وفي حكاية محمود الدهمان (باقي هناك) الذي عاد متسللا إلى البلاد، بعد هجرته الأولى منها، وهي الحكاية التي تكاد تكون منقولة نصا عن "المتشائل"، دون أن يخفي الكاتب ذلك، لدرجة أنه يستخدم اسما مشابها لاسم باقية في رواية إميل حبيبي المهمة، لسبب واضح، هو أن يوهم نفسه بأنه ينسج على منوالها، وهو كثيرا ما يكرر اسم حبيبي دون سبب، سوى وضع رابطة بينهما، ككاتبين، أو عقد مقارنة، بهدف أن تعلق هذه الرابطة، غير القائمة، في ذهن القارئ.
من باب التثاقف أيضا، يسرد الكاتب "رواية داخل رواية"، حين يقرأ ـ كخبير أدبيّ بالطبع ـ مخطوطة تكتبها جنين، تحمل بكل بساطة عنوان "فلسطيني تيس". في هذه "الرواية" بالذات، وهي مفتعلة بكاملها، نتعرف على باقي هناك، وحكايته التي تتكرر كلما عاد الكاتب إلى متابعة قراءته للرواية (التي يناقشها مع كاتبتها أساسا، لأنه يهتم بالتعرف على حياتها، بدلا من كتابتها)، مع أننا منذ البداية ـ كقراء ـ نعرف أنه ترك عائلته الأولى وعاد، وشكّل عائلة أخرى، وحياة أخرى، منسجمة مع الاحتلال، حتى حين يفتعل مقاومته، دون أن يعيد علينا الكاتب سرد حكايته مرة بعد مرة، حتى يتوصل في النهاية إلى استكمال هذه الحياة، حين يعود إلى غزة زائرا، بعد احتلال 1967، حيث يتكرر الحديث عن الاحتلال الأول، وعن هجرته الأولى دون غيره (ص 120). في هذه العودة يبحث عن بقايا عائلته، ليكتشف أن الذي لم يقتل منهم جنّ، وأنه هو الوحيد الذي كسب حياته، إلى جانب جارته اليهودية التي تتهمه زوجته ـ الثانية ـ بأنها خربطت عقله. وإذا كان هذا البقاء، والعودة الباحثة عمن بقي في الهجرة، يمكن أن يفسرا بعدة طرق، إلا أن ما تطرحه الرواية بمجملها سوف يساعد على اختيار تفسير بعينه، لأنه يجري التأكيد عليه باستمرار.
لكن أطرف ما يتكرر في الواقع هو طرح اسم الكاتب مرة بعد مرة في روايته، ومحاولة شخصيات روايته القديمة أن تتحدث معه عن مصائرها، في نرجسية ممجوجة يكاد القارئ ـ بسببها، وأسباب أخرى ـ يقذف بالرواية حنقا، عندما يواجه هذا الإعلان الدعائي فيها لأول مرة في صفحات عدة (ص ص 163 ـ 170)، حين تطل على المشهد مؤخرتا الكاتب وزوجته ـ في تكرار لمثل هذه الصورة ـ عندما "رمى بمؤخرته على المقعد المقابل لنا (الراوي هو وليد دهمان) بطريقة ستعاتبه مؤخرته عليها، وجلست المرأة إلى جواره، بحرص أنيق على مؤخرتها"، لكنه يعود ويبتلع الغيظ وهو يرى ذلك يتكرر، بإصرار ما بعده إصرار!
إن الحديث عن جولي وأمها، والوصية يتكرر، والحديث عن جنين وعلاقتها بزوجها، وضيق زوجها بواقعه في يافا يتكرر، والحديث عن غزة، وشوق الوالدة يتكرر، والحديث عن القطار، الذي يجرّ حديثا عن قطار آخر يتكرر، وربما كان ذلك بهدف "تعليم" القارئ ما لم يتعلمه من المرة الأولى.
ومن الطريف أن الكاتب يفصل ويخرج عن السياق إلى حكايات من توارد الخواطر، حين يفترض الاختصار، لكنه يقفز عن التفصيل حين يكون ذلك لازما، كما هو الحال في موضوع معرفة الراوي بجنين، فهو يقول وحسب: "تعرفت إلى جنين قبل ست سنوات، خلال توقف قصير لها في لندن، في طريقها إلى نيويورك. حينذاك، استضفتها على عشاء في البيت في غياب زوجتي التي كانت خارج البلاد" (ص 124). وبالرغم مما في هذا النوع من التعارف غير الواضح من افتعال، إلا أنه لا يكفي لتحوّل العلاقة العابرة، التي لا تفهم ظروفها، ولا الدافع إليها، بداية، رغم نسبتها بعد ذلك إلى صلة القرابة، إلى علاقة حميمية بسرعة، لا تكفي لعرض عمل روائي مخطوط على الكاتب الشهير، ولكنها تتحول إلى نوع من الحميمية التي توحي بالحبّ، أو على الأقل بما يسمح بالبوح بالأسرار الخاصة، على فنجان قهوة (ص 135).
ويدخل في هذا التكرار بالطبع سرد ما هو معروف للجميع، حول الأماكن، والمعارك، والأحداث الشهيرة، أو ما هو متاح من ذلك لمن يريد أن يعرف، وهو يشكل عبئا كبيرا على الرواية، يجعل ما يتبقى منها للسرد الروائي الحقيقي شيئا يسيرا.
4 ـ فواتح نرجسية
كلّ هذا الإحساس بالفوقية تجاه القارئ، ينبع من حسٍّ نرجسيّ عال، يتحول إلى تعظيم للذات بشكل يمنع عنها رؤية أي خطأ فيما تفعل. وهذه الأنا المتضخمة لا تخفي وجودها عبر الرواية كلها، لا من خلال الاستعراض الزائد للمعرفة وحسب، وإنما من خلال التصريح المباشر بهذا الإحساس.
إن أول بوادر هذا الإحساس هو المحاولات المتواصلة لوضع الذات في موازاة إميل حبيبي "الرائع". وقد يأتي ذلك من خلال الإلحاح على ذكر حبيبي، حتى دون مناسبة، كما قد يتجاوز الأمر لوضع مقارنة هادفة بين حبيبي والكاتب، سواء جاء ذلك من خلال وليد دهمان، الشخصية الرئيسية في روايته، أو من خلال المقارنة المباشرة بين إميل حبيبي، وربعي المدهون مباشرة، على لسان شخصيات مختلفة.
جنين مثلا، بعد أن تصف إميل حبيبي بأنه "الرائع"، وتطلب من زوجها، القلق من وجوده في يافا بعد أمريكا، التعلّم من المعلم، تتحدّث عن وليد دهمان، الذي كتبه ربعي المدهون، بهذه المباشرة الفجة: "قبيل عودتنا الأخيرة، رويت له ما دار بيني وبين وليد دهمان، قريبي الروائيّ المقيم في لندن، وكان يعجبني كثيرا ما يقوله، وكنت أقتبس عنه، حتى إنني لم أخف تأثري بأسلوبه، ولم أنكر يوما ما تركه وليد من بصمات على كتابات طلبت منه مراجعتها" (ص 89). وهكذا يكون دهمان ـ المدهون، خبير كتابة، لا يتردد الآخرون في الاعتراف بأنهم يستشيرونه ويقلدونه.
وهو معجب بنفسه أيضا، لدرجة أن إحدى النساء، عندما جرى تطهيره، قامت بقلي ما قطع منه، بزيت الزيتون، وتناولته مساء مع رغيف ساخن، فما كان منه إلا أن خمّن، وهو طفل "أنها نامت ليلتها مع زوجها أولا، قبل أن تنام عميقا مع أحلامها بصبيّ يأتيها من حمل ساهمت (تلك القطعة) فيه" (ص 119). وفي مقام آخر، وحين يسمع ما يروى من أن "الحامل إذا مرقت من تحت الصخرة بتطرح وبتسقط اللي في بطنها" لا يتردّد في القول: "حمدت الله حين سمعت ذلك، أن زوجة عمي لم تقل هذا الكلام لأمي أثناء حملها بي، لكانت المرأتان طوّرتا معا معتقدا عجيبا يقضي عليّ بينما لم أزل جنينا" (ص 229)، ربما سيخسره العالم.
لكن الأمر لا يتوقف عند التخفي وراء وليد دهمان، بطل الرواية، لأن ربعي المدهون نفسه سريعا ما يظهر باسمه الصريح في روايته، في نوع من الاستعراض لا أظن أن تاريخ الرواية عرفه حتى الآن: كان وليد دهمان (مع زوجته الأجنبية) يجلس على مقعد خشبي عريض في مطار بن غوريون في اللد، انتظارا للتحقيق، عندما دخل الى قاعة النكد المفتوح تلك، رجل في مثل سنه، "ذو سحنة عربية مغبرة بمتاعب تشبه ما على ملامحي (...) اعتدل الرجل فجأة، وتخلى ظهره عن الحائط، راح يتأملني ويقرأ ملامحي كمن يراجع بيانات اطلع عليها من قبل. كأنه يعرفني! هل حقا يعرفني؟ شككت. لم يسبق لي أن رأيته من قبل، أو رأيت السيدة الأنيقة التي ترافقه. ربما يعرفني! كثيرون يعرفونني ولا أعرف أنهم يعرفونني" (ص 164). إن الكاتب يتماهى تماما مع بطل روايته، حتى في الملامح، ولكنه لا يستطيع أن يستمر في هذا التماهي، فهو يترك الصحيفة التي يحملها عندما يستدعى ـ ومؤخرته بالطبع، ومؤخرة زوجته، بسبب ما يوليه الكاتب للمؤخرات من اهتمام ـ للتحقيق، دون أن يدري القارئ لماذا يستدعى قبل بطل روايته الذي كان ينتظر قبله، سوى من باب الافتعال الذي يجعله يترك جريدة كان يحملها، ليكتشف البطل، حين يلتقطها، وجود مقال فيها، وليفاجأ، كما يفاجأ معه القارئ، ويفاجأ فن الرواية ذاته، باسم كاتب المقال: ربعي المدهون. وحينئذ تنطلق "يا إلهي" في وقتها تماما، من الرواية والقارئ معا: أبمثل هذا تكتب الروايات؟
مع هذه النرجسية العالية، لا يتوقف الكاتب عند حدّ، في استعراض ذاته، بل يكرّر، على لسان بطله القديم الجديد قائلا إن المدهون قد يعمد "إلى تغيير مسار رحلتي كلها، فهو المؤلف، وخالق شخصيتي التي أظهر بها الآن" (ص 170). ثم لا يفتأ يكرر استعادة المشهد نفسه، ليورد اسم الكاتب مرة بعد مرة، ويعلن عن شهرته وأخباره وصوره، بإلحاح يثير الاستغراب وخلافه. البطل السائح يسمع من صديقه الذي يحمله من المطار تلك الحكاية ذاتها: "من شويّ شفت زلمة طالع من المطار مع مرة كأنها مرته، حسيت فيه شبه من الكاتب ربعي المدهون.. ابتعرفه للمدهون؟"
"لا والله بس بقراله أحيانا.. اليوم شفته؟"
"إلا مبارح يعني! إسه من شوي شفتهم اثنيناتهم طالعين ومع
