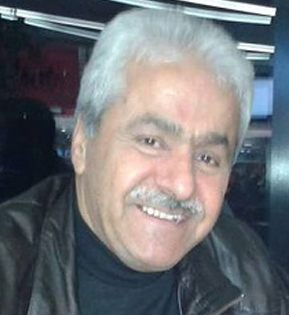

تيسير الزَبري
منذ فترة ليست بقصيرة، وهناك سؤال يدور في رأسي يبحث عن جواب وتفسير للكيفية التي جرى التعامل بها من قبل بعض فئات نخبوية (أحزاب أو أفراد) “يساريون” أو ديمقراطيون علمانيون، مع الانتفاضات الشعبية في عدد من الدول العربية وما أطلق عليه بـ (الربيع العربي)، منذ نهايات العام 2010 وحتى اليوم.
أعترف بأن المفاجأة من ردود الأفعال كانت صادمة أكثر مما توقعت، ففي الوقت الذي أثارت الحادثة المفجعة ممثلة بانتحار الشاب التونسي بوعزيزي احتجاجاً على الجوع والقمع، كانت أطراف المعارضة منها اليسار التونسي تقارع بعضها بقضايا ثانوية، ويتهم بعضهم بعضاً، وعندما تنبهت إلى ما جرى كانت حركة النهضة الإسلامية تقطف الثمار، وما زال الصراع قائماً والمخاطر قائمة.
أما في ليبيا، فحيث كان الفراغ السياسي هو السائد باستثناء حزب النظام (المؤتمر الشعبي) فإن الثورة الشعبية أخذت وما تزال إتجاهات ميليشياوية (متطرفة) وتكاد تكون الدولة غائبة، واحتمالات التقسيم والانقسام هي الأكبر في ظل غياب قطب ديمقراطي أو حتى ليبرالي اصلاحي، بالرغم أن رموز هذا التيار قد لعبوا دوراً هاماً عند إنطلاق انتفاضتهم!
أما في مصر، فقد نشأت في هذا البلد المحوري عربياً واقليمياً ظواهر شبابية من أصول فقيرة، ومتوسطة نخبوية وغير جماهيرية، لكنها فاعلة مستفيدة من استخدام وسائل الإتصال الحديثة، برزت بسببها على السطح السياسي وبدا وكأن لا أحد غيرها على الساحة من الأحزاب التاريخية المصرية!.
القوة الكامنة ممثلة بحركة الإخوان المسلمين كانت الأقدر على استثمار نتائج الثورة المصرية لأسباب تاريخية، وبسبب من الخبرة المتراكمة، وحالة الفقر الواسعة، والوعود التي أطلقتها بحياة أفضل، وحياة أخرى خالدة في جنان النعيم إضافة إلى حالة الانقسام بين القوى الديمقراطية وانحياز بعض الاتجاهات الشبابية المتطرفة إلى مرشح الإخوان المسلمين!
الانتفاضة المصرية الثانية في الثلاثين من حزيران الماضي تضع الآن مصر على طريق تجديد الثورة، وإعادة مصر إلى دورها التاريخي، وتحمل بشائر نقل الأوضاع المصرية الاقتصادية والاجتماعية إلى مواقع أفضل بعيداً عن الفساد الذي استشرى، ومخاطر التوريث، واستعادة الدور السياسي الإقليمي.
في مصر أيضاً، وفي ظل غياب مركز الاستقطاب الديمقراطي التقدمي الجاذب لأوسع الجماهير فإن تيارات عدمية ونخبوية لا ترى في إنحياز العسكر الى صفوف الثورة (25 يناير + 30 يونيو) سوى سيطرة للجيش على مقدرات الثورة، وهم يواجهون استجابة المشير السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية بالرفض والشك، ويرفعون شعار “يسقط حكم العسكر” وهو ذات الشعار البائس الذي تورط البعض في رفعه في ثورة يناير وفي ميدان التحرير في الوقت الذي كان ينحاز فيه الجيش (المجلس العسكري – الطنطاوي) إلى الثورة، وهم يكررون ذات الشعار اليوم بعدما انحاز الجيش المصري إلى حركة التصحيح في 30 يونيو العام الماضي! من المؤمل أن ينتهي هذا الجدل لصالح الاختيار الذي يقرره الشعب المصري دون تعسف أو خوف من أي تيار نخبوي أو شمولي.
الدليل الأبلغ على انحراف البوصلة هو النظر إلى ما يجري في سوريا، بمواقف دوغماتية (جامدة) لا ترى في الصراع سوى اسوأ اشكال القوالب الإيديولوجية المحنطة.
من المشروع تماماً إظهار الخلاف مع النظام السوري والرئيس بشار الأسد سواء من سوريين معارضين أو حتى من غير السوريين في حال كان الصراع سورياً – سورياً أي لو كان صراعا داخليا ديمقراطيا، وربما كان مشروعاً أن يعبر البعض من النخب اليسارية عن تأييده للمعارضة الداخلية السورية، ولكن ما يدور راهناً لم يعد له علاقة بحركة معارضة سورية سلمية ضد النظام، بل انها معركة تقودها قوى اقليمية معروفة، ودولية حتى أن اسرائيل تشارك بها، وهذه القوى تستخدم معارضة متعددة الالوان، خطيرة ليس على سوريا فقط بل على عموم المنطقة، البعض يضعها على قوائم الارهاب الدولي، ويدعمها بذات الوقت!! وهذه معركة وإن كان ظاهرها يطرح شعار إسقاط الأسد لكن جوهرها اسقاط سوريا وتفتيتها لدول طائفية تطال بنتائجها كل الدول المجاورة وقوى المقاومة، بما في ذلك ما سوف تتركه (لو تمكنت من سوريا) من آثار خطيرة على القضية الوطنية الفلسطينية.
بالرغم من الوضوح الظاهر في اتجاهات التصفية لدور مصر، وسوريا تطبيقاً لسياسة كونداليزا رايس (بالفوضى الخلاقة) فإن ذات النخب البرجوازية الصغيرة، المفتونة بالديمقراطية الشكلية لا تنظر إلى مصلحة الغالبية العظمى من الشعب الراغبين في حياة جديدة حرة وديمقراطية، مستقرة بل تحكمها مفاهيم (ايديولوجية ما) جامدة لا علاقة لها بمصالح الناس وانحيازاتها، ولا تضع لمعادلة اخضاع التناقض الثانوي للتناقض الرئيس أي اعتبار .. والحديث عن هذا السلوك يطول.
