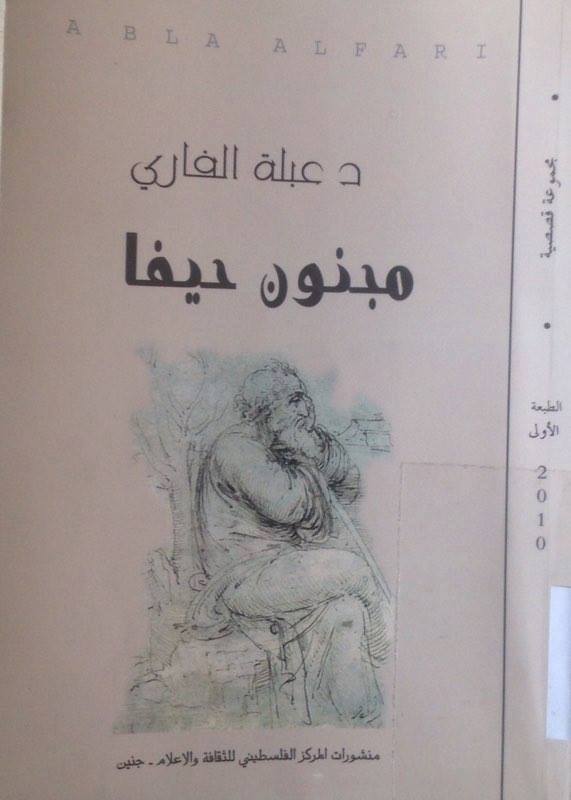
للكاتبة: عبلة الفاري (2-2)
في ظل متاع بطل القصة والتي لا تنتهي، يقرر الهجرة إلى الخارج، لعله يتخلص من كوابيسه، وفي النهاية لن يلحظ أحد غيابه، أهل القرية سيقولون كلب ومات، فهناك الكثير من ابناء الشاطىء. وأمه لن تلحظ غيابه، وهي مشغولة دائما في معركة غسل الصوف على الشاطىء لتأمين أرغفة الخبز الممتزجة بالعرق والشقاء والذل، فهي ترجع ليلا منهكة، تعد بعض الطعام لصغارها، ثم تنام لتستيقظ على نفس المعركة التي لا تنتهي، أما الأب فدائم السعال، ولا يعود إلى البيت إلا في وقت متأخر مهملا أولاده، يوقظ المرأة التعبة لتحضر له العشاء، وإذا كان في مزاج عكر يضايقها ويضربها، مما أجبر مسعود على ضربه بعمود خشبي على رأسه، وهرب ليعيش بجانب مزبلة القرية.
يحس مسعود بأنه زائد في الحياة، وأنه مخلوق قذر، وأهل القرية أطلقوا عليه لقب البغل. ويشعر أيضا بتأنيب الضمير لخيانته صديقه منصور، ويصمم على الرحيل إلى البعيد، يقول: "هناك خلف ذاك المدى البعيد أسمع صدى الرحيل يتردد من وراء تلك الجبال الشاهقة ويناديني ليحثني على الإسراع". (ص 33)
فالاغتراب ما هو إلا قلق ويأس يؤثر على النفس البشرية. ومن ناحية علم الاجتماع فقد تحدث العلماء عن عجز الإنسان عن التأثير في المواقف الاجتماعية التي يتفاعل معها، وشعوره بدونيه، والإحساس بالرفض المجتمعي وسيطرة فكرة الانعزال عليه. وانعدام الثقة بالأفراد والمجتمع بالنسبة للمغترب الذي يحس إن كل أعماله منتقدة وغير مفيدة وبالتالي التردد والشك، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.
يمني مسعود النفس أنه سيجد في بلاد الغربة ما يصبو إليه بعيدا عن مزابل قريته، والناس المتلونة بكل لون، وأنه سيعيش كإنسان. هرب مسعود دون مال أو علم أو مهنة، هرب وهو يحمل النقمة على نفسه وزمانه وواقعه، هرب مشحونا بالغضب والقهر من واقع متخم بالمرارة والشقاء.
والإنسان في هذه الحالة "لا يعود ممتلكا لناصية جوهره وهكذا فإنه يغرب ذاته عن طبيعته الجوهرية أو يصبح مغتربا عن ذاته". (6) كما يرى هيجل علاقة الإنسان بمجتمعه.
فالذات عندما تصدم بالحواجز المجتمعية مثلا، وتتوقف عن نموها الطبيعي، أو "أضفي الغموض عليها أو تعرضت للإختناق، فهي ذات تعيش حالة اغتراب ذاتي". (7)
وفي البلاد الغريبة سيجد إناس يتحدثون بلغة لا يفهمها، يتعثر بحياته، ولا يجد لقمة الخبز لتسد جوعه، ويحاول أن يدوس على وجعه، ويستمر في محاولة إيجاد نفسه دون جدوى "أبحث عن ذاتي فلا أجدها وأدخل في دوامة أو كابوس بلا بداية ولا نهاية". (ص 35)
يعود إلى الماضي فلا يجد فيه سوى الحزن والألم، ويقول لنفسه: "يجد الكلب عظمة في المزبلة تسكن جوعه، أما أنا لا أجد حتى ذاتي التي أهلكني البحث عنها بين غبار الطرقات وأكوام النفايات". (ص 35-36) وعندما تقفل كل الدروب في وجه يتمنى الموت لينتهي من هذا الألم والضياع. وظل مسعود يسير في حياته هائما وحائرا يحلم بالعودة إلى الوطن، حتى كتبت إحدى الصحف المحلية عن موت مهاجر لا شرعي، مجهول الهوية في ظروف غامضة.
اختارت القاصة أن تكون قصتها "مجنون حيفا" لتكون الأخيرة، وتكون عنوانا للمجموعة القصصية، لأنها تشعر أنها مهضومة الحقوق، وأن الزمن لم ينصفها إذ تسبب الاحتلال بطرد أهلها من بيتهم الحميم وقريتهم، لذا فالشعور الطاغي في قلبها هو: متى سنعود إلى حيفا؟ ولجأت القاصة إلى حيلة الجنون التي أصابت شخصية القصة لتحقيق الحلم، كما اختارت السارد العارف بكل شي عن شخصيته، لتخبرنا عن أوجاعه وأحلامه والظروف التي أوصلته إلى الجنون.
المجنون الذي يسكن كراج جنين الخاص بالحافلات، والذي تشتت أسرته، وتركه ابنه وهاجر إلى أمريكا بحثا عن مستقبل أفضل، واقام الراوي صداقة معه، حيث كان يزوده بالفطور والقهوة كل يوم، الراوي الذي يدرس التاريخ في جامعة النجاح كان مهتما برواية المجنون العم منصور حول التهجير، لذا كان يجلس معه محاولا أن يستخلص منه حكايته، وهو يشبه جدة الراوي، وكأن كل كبار السن المهجرين يشبهون بعضهم البعض، يقول الراوي عنه أنه يشبه جدتي، فهو عذب الحديث مثلها "رقيق القلب، واسع الثقافة رغم شروده وجنونه". (ص 100) والجدة تحتفظ بالمفتاح القديم في عبّها، والعم منصور يحتفظ به في حزامه.
في أحد الأيام يختفي العم منصور، فيبحث عنه الراوي في المستشفيات وفي كل مكان لعله يعثر عليه دون جدوى.
حتى يقرأ في أحد الأيام عن دهس سائق مخمور في حيفا رجل كهل ومختل العقل ويحمل في حزامه مفتاحا كبيرا.
إن محاولات العم منصور من أجل الوصول إلى حيفا كلها باءت بالفشل، ولكنه نجح أخيرا بالوصول إليها بعد أن فقد عقله، ولم يعد يعي المخاطر التي ستواجهه في الطريق إليها إذ ينتشر جنود الاحتلال على الحواجز لمنع أو قتل كل فلسطيني يرغب ولو بزيارة مدينته الضائعة، فالجنون وسيلة الإنسان الهش الذي يعجز عن تحقيق ما يصبو إليه فيهرب إلى الجنون لأنه يعود بلا عقل غير إن الشخصية هنا تفقد ذاكراتها الحاضرة، وتتعلق بالماضي الجميل.
فشخصية المجنون هنا تشعر بالاغتراب الذي هو "عملية صيرورية تتكون من ثلاث مراحل متصلة اتصالاً وثيقاً". (8) المرحلة الأولى تنشأ نتيجة وضع الفرد في البناء الاجتماعي، والمرحلة الثانية تتشكل بسبب وعي الإنسان بوضعه، أما المرحلة الثالثة "فتنعكس على تصرفه إنساناً مغترباً على وفق الخيارات المتاحة أمامه". (9)
فالعجوز خسر بيته ومدينته ومن ثم خسر ابنه، لذلك أصبحت الحياة بالنسبة إليه فارغة ولا تستحق العيش، وارتبط المكان في وعيه بحياته الماضية المليئة بالمسرات والخيرات، والمكان ارتبط عند الكاتبة "ارتباطا وثيقا بوعي الإنسان واحساسه، ويعكس ما تعانيه الشخصية من قلق وحسرة وخيبة ومعاناة". (10) فالمدن كلها متشابهة، وهي قاسية وغير مبالية بألمه، ولا مدينة ستحتضنه وتحن عليه غير المدنية التي ولد وعاش فيها، وبما أن حيفا مدينة محتلة ولا يمكن له العودة إليها للعيش فيها، فلم يتبق له سوى رؤيتها للمرة الأخيرة قبل الموت.
أما في قصة "الامتحان الأول" فنرى شخصيتها "حسن" غارق في قراءة الكتب الأدبية والفلسفية، ولكن هذا الأمر يسبب له المشاكل وسخرية الأهل والأصدقاء، ويقول لنفسه وهو يتفقد كتبه (غوته، شوبنهاور، هيجل، نيتشه، المعري، المتنبي) إن هؤلاء الأشخاص قد سيطروا على فكره، وهم "المسؤولون عن تعسي وشقائي في هذا الزمن، فلو لم تكونوا هنا، لما وصلت إلى هذا الحال، أسير في الطرقات ضائعا أحدّث نفسي، أعيش في أقصى منافي غربتي وأنا بين أهلي". (ص 16-17)
وفي لحظة يأس، وبعد أن نال من سخرية الجميع ما نال، قرر حرق كتبه، يقول" إنّ أغراض الثقافة قاتلة لدرجة أنّهم ألصقوا بي تهمة المجنون، لأني ولدت سوسة تنخر الكتب لتعيش وتهمة المتخلّف لأن خمرتي المعتقة هي القهوة المرّة، وتهمة المعقد لأني جاهل في التعامل مع الجنس اللطيف". (ص 18)
فما حصد من ثقافة الكتب إلا الهزء والمعاناة، فالزمن مصاب بداء السطحية والقشور، والناس لم يعد يهمها سوى المال، وبحرقه لكتبه، وشربه للخمرة، ومضاجعته للنساء يشعر أنه تحرر من التهم المنسوبة إليه، يرجع إلى غرفته سعيدا، ولكن في الطريق إليها تصطدمه شاحنة كبيرة وتقطعه أشلاء، وهنا ينهض من كابوسه مذعورا، وعندما يهدأ يدرك أنه كان في حلم بائس ومخيف، وأنه ليس مجرد قشرة بين القشور "ولست ورقة خريف صفراء تعبث العواصف بها...أنا شيء آخر هو الإنسان". (ص 25) الإنسان القادر على اجتياز الأوجاع والحواجز. فالاغتراب الذي أحس به حسن لم يجعله يستكين ويستسلم بل دفعه إلى الأصرار على تحقيق هدفه غير عابىء بسخرية الناس وهزئهم.
وكذلك تفعل البطلة في قصة "نسائم الذكريات"، إذ نرى البطلة تعاني بسبب وفاة والدتها صغيرة، ومن قسوة زوجة الأب، إلا أنها كانت تجد المواساة في الصعود إلى شجرة سنديان، تجلس تحلم بغد أجمل، حتى جاء اليوم الذي قطعت فيه الشجرة، وصارت البطلة دون معين. أخذها خالها بعيد وقام بتربيتها والاعتناء بها حتى أصبحت معلمة، وعادت إلى قريتها لتعلم أطفالها معنى الألم والإرادة، تقول: "تجول بخاطري نسائم الذكريات وأستهجن لهذه الإرادة التي غرستها قسوة الحياة في أعماقي لأثبت بها لنفسي أنّ رغبة الحياة أقوى مليون مرّة من نعيق الموت". (ص 66)
وفي النهاية لا بد من القول أن القاصة عبلة الفاري، كاتبة غاضبة ومقاتلة بقصصها، وأنتجت في بواكير مشروعها الأدبي مجموعة من القصص المكتملة فنيا، والملاحظة الوحيدة على بعض القصص إن الكاتبة استهلتها بشيء يشبه الخاطرة الشعرية، وهذا يجعل القارىء لا يقفز إلى دراما القصة مباشرة، ويتشتت فكره.
