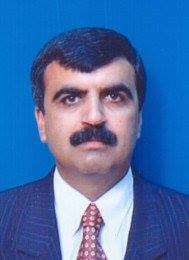
ما من مذهب فكري أو منهج علمي أو مبدأ اجتماعي أو معتقد ديني إلا وكان التعاون عنصراً مهماً فيما يدعو إليه ، بل منطلقاً أساسياً ينطلق منه نحو بلوغ غاياته ، لِما للتعاون من أثر نفسي ومعنوي على الأطراف ذات العلاقة بهذا الأمر ، ولما له أيضاً من أثر مادي وعملي في تيسير الإنجاز وتسهيله ، وفي اختصار الوقت والجهد ، وفي توفير المال ، وذلك أثناء العمل لتحقيق الأهداف.
ولم يكن التعاون في تراثنا الديني والاجتماعي بالأمر الغريب ، ولا بالطارئ العجيب ، فقد كان جزءاً من هذا التراث من أزمنة الآباء والأجداد ، ولذلك فقد وُجد التعاون في مجتمعنا ـ كما هو الحال في المجتمعات الإنسانية الأخرى ـ وقد أطلق عليه الناس في بلاد الشام ومنها فلسطين مصطلح ( العونة ) ، وتعني المساعدة في إنجاز عمل يخص أحد أبناء المجتمع ، أو أفراداً منه ، أو المجتمع المحليّ ككل. وقد شجعت التعاليم الدينية السائدة في المجتمع مبدأ التعاون ، ومنها الأمر الإلهي في القرآن الكريم ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، والبرّ هو الإحسان ، لا بل إن مبدأ التعاون هو عقيدة متأصلة في المجتمع العربي منذ الجاهلية ، فالكرم العربي الذي نفخر به ونعتز ، ما هو إلا مظهر من مظاهر التعاون الذي أوجدته ـ كما يرى الكثيرون ـ البيئة القاسية في شبه الجزيرة العربية.
وإذا عدنا في مجال حديثنا عن التعاون إلى فلسطين ، نقول إن مبدأ التعاون كان أكثر إلحاحاً ، في هذه القطعة بالذات من الأرض العربية ، وذلك منذ النكبة وحتى الآن ، بحكم الضرورة ، فالنكبة التي ابتلت فلسطينَ وأهلها ( بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ) أوجبت على أبنائها المنكوبين التعاون للصمود من ناحية ، ولتوفير متطلبات الحياة من ناحية أخرى ، فأصبح التعاون في هذا الوضع جزءاً من (الحالة الثورية) التي يعيشها أبناء الشعب بشكل عام ، في معركة البقاء ،وهو الأمر الذي تطور فيما بعد ليبدو أكثر تنظيماً فيما عرف بـ ( العمل التعاوني ) أو ( التطوعي ) الذي تبنته أهم الأطر السياسية في الساحة الفلسطينية ، والذي بلغ وقته الذهبي في الثمانينيات من القرن الماضي قبل انطلاق الانتفاضة الأولى وبُعيد ذلك ، وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد فقد بريقه مع بداية التسعينيات ، إلا أنه استمرّ بشكل يتصف بالجدية حتى خرجنا من ( الحالة الثورية ) بصورتها النمطية ، ولو بشكل ( رسمي ) أو نظري ـ حتى لا نتجادل في التسميات ـ ودخلنا فيما يمكن أن نسميه ( حالة أوسلو) وما تبع ذلك من مرحلة ( بناء مؤسسات الدولة ) بشكل عملي.
إنني لا أستطيع ، ولا أريد كذلك ـ في هذا السياق ـ أن أتحدث عن مقدار ما أنجز في هذه المرحلة ، وتحت هذا الشعار من إنجازات ، فأنا لست من أهل الاختصاص ، من جانب ، كما أن هذا الأمر ليس من شأني في هذه السطور من جانب آخر ، أما الذي من شأني وأنا أتحدث عن العمل التطوعي ، فهو أن أُشير إلى أن الاهتمام بهذا النوع من العمل في هذه المرحلة قد انحسر ـ كما أسلفتُ ـ إلى حدّ كبير ، رغم استمرارية وجوده ، بهذا الشكل أو ذاك ، وأنا هنا لا أسمي المتطلبات الدراسية أو الخدمات المجتمعية التي تفرضها بعض المؤسسات التعليمية وغيرها على مرتاديها عملاً تطوعياً ، وإن سُمّي كذلك ، فالعمل التطوعي هو تطبيق لتوجه ذاتي ، ولذا فإنه لا يكون بمرسوم علويّ ، ولا يتأتى بقرار وظيفيّ !
وهنا ، قد يتساءل البعض عن السبب في انحسار ظاهرة العمل التطوعي في هذه المرحلة ، وهو تساؤل واقعي ومنطقي . وفي محاولة للإجابة عن هذا التساؤل أقول : إنني أرى ـ وهي وجهة نظر ـ أن وراء هذا الأمر عدة أسباب ، من بينها سببان رئيسان : السبب الأول يتعلق بتغير نظرة بعض أبناء المجتمع إلى الفكرة بحد ذاتها ، ففي المرحلة التي سميناها ( الحالة الثورية ) ، بصورتها النمطية ، كان الناس ينظرون إلى العمل التطوعي ، مهما كان مجاله ، على أنه الجانب الاجتماعي أو المدني من العمل الثوري ، ولنقرب الفكرة أكثر نقول : إنه كعمل الممرضة المتطوعة في أوقات الحرب . أما السبب الرئيس الثاني في انحسار فكرة العمل التطوعي ، فإنه يتعلق بحالة الإحباط والمرارة التي أصبح يعاني منها الكثيرون في ظل انتشار البطالة ، وخاصة بين الخريجين ، وما يشاع عن وجود بعض المظاهر السلبية كالمحسوبية والفساد ، وهو الأمر الذي يمكن أن تحدد درجته ومداه الجهات المختصة كهيئة مكافحة الفساد ، وكذلك منظمات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.
لا شك في أن هذين السببين الرئيسين ومعهما بعض الأسباب الأخرى ، قد قللا من جاذبية فكرة العمل التطوعي في مرحلة بناء المؤسسات ، ولهذا ، فإن أبناء المجتمع الذين يقعون تحت تأثير السبب الأول عندما تطلب منهم ممارسة نوع من العمل التطوعي في مجال من المجالات يقولون : الآن لدينا مؤسسات وهذا واجبها . أما إخوانهم الذين يقعون تحت تأثير السبب الثاني ، وهو الإحباط ، فلربما كانت ردة فعلهم بسبب ما يشعرون به من المرارة أكثر حدة ، فيردون على من يقترح عليهم التطوع في العمل بردّ لا يخلو من لهجة انتقامية : فليعمل الذين أخذوا الوظائف ويتقاضون الرواتب.
لكن من ينظرون إلى الأمر من زاوية الدافع الوطني والإنساني المجرد ، مزوَّدين بتجربة الثمانينيات من القرن الماضي الناجحة في هذا المجال ، وبالشحنة التي أوجدتها في نفوسهم هذه التجربة من حب للعمل التطوعي ، فإنهم يقولون غير هذا ، وهم يدعون المؤسسات الإعلامية والاجتماعية والتربوية إلى إعادة غرس قيمة العمل التطوعي كواجب اجتماعي ووطني وديني وإنساني في النفوس ، حتى نمد المجتمع بأسباب القوة ، ونبسط أمام أفراده سبل النجاح، ونحن نستذكر قول الشاعر:
وبلوت أسباب الحياة وقِسُتها = فإذا التعاون قوة ونجاحُ !