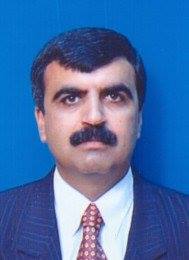
تلجأ بعض الأطراف المتصارعة على مصالحها في الكثير من البلدان التي تُغيّب القانون الرسمي ـ بهذا القدر أو ذاك ـ عن ممارساتها اليومية، ومنها البلاد العربية، إلى شرعيات بديلة ـ وقد تكون مصطنعة أحياناً ـ لتستند إليها عوضاً عن القانون الذي اتُّفِق عليه بين أبناء الأمة، وأقرّ في مؤسساتها، والذي من المفترض أنه يستند في الأساس عند وضعه ـ ضمن ما يستند إليه ـ إلى التعليمات التي تنص عليها تلك الشرعيات البديلة.
والشرعيات البديلة في هذه البلدان أنواع، منها ما يُلبسها أصحاب الشأن عباءة الدين ، والدين منها براء ، والتي يسميها هؤلاء وأنصارهم الشرعية الدينية ـ وأنا هنا لا أتحدث عن الشريعة السمحاء التي لا خلاف عليها ـ والشرعية الأخلاقية ( الإنسانية ) والشرعية السياسية ، وأقصد بالشرعية هنا المرجعية الفكرية التي يستند إليها هؤلاء في تبرير تصرفاتهم .
إنني هنا أريد أن أشير إلى واحدة من هذه ( الشرعيات ) وهي الشرعية التي يمكن أن نسميها ( الشرعية السياسية ) ، وهي ـ كما أرى ـ كقطعة النقد ، لها وجهان ، وجه تراه الطبقة الحاكمة ، ومن يلتف حولها من أصحاب المصالح وأرباب النفوذ الإعلامي والاقتصادي وغيرهم ، وتتراءى هذه الطبقة وبطانتها في هذا الوجه صورة ( الوطنية ) ، ووجه آخر تراه المعارضة السياسية ومن يلتف حولها من المواطنين العاديين وشريحة المثقفين وتتراءى فيه صورة ( الديمقراطية ) . وكلا الطائفتين تعلق الصورة التي تناسبها على صدرها لتتباهى بها وتتقوى أمام الناظرين ، وتعلن أنها صاحبة الشرعية السياسية .
وعلى الرغم من أن كلاً من الطائفتين المتصارعتين في بلد مستقل يتمتع بالسيادة على أرضه يمكن أن يستند إلى الشرعية السياسية ، بشكل منطقي ومبرر في مغالبته للخصوم ، كتلك الحالات التي تتأكد فيها الفئة الحاكمة من أن المعارضة ـ أو البعض منها ـ يثير الفتنة ويسيء إلى السلم الأهلي فتعلن الحرب على خصومها تحت لواء ( الوطنية )، وكذلك في الحالات التي تتيقن فيها المعارضة من أن الفئة الحاكمة ، ومَن حولها ، يتجاوزون القانون من أجل المحافظة على امتيازاتهم أو زيادتها ، ولا يأخذون رأي الناس في أمور الوطن ، فتعلن هذه المعارضة الخصومة على تلك الفئة الحاكمة تحت راية ( الديمقراطية )، إلا أن كلتا الطائفتين وفي كثير من الحالات تتخذان من هذه الشرعية ( السياسية ) حجة وذريعة لزيادة المكاسب وتحقيق المآرب ، ولا تعني ( الوطنية ) أو ( الديمقراطية ) بالنسبة إليهما سوى شعار وسيف ترفعه هذه الفئة ضد تلك ، بمعنى أن كل طغيان الحكم والسلطان يعلق على المشجب الوطني ، وكل انفلات المعارضة ودسائسها يعلق على الشماعة الديمقراطية !
فإنك تجد الطبقة الحاكمة على سبيل المثال ، وفي كثير من الأحيان ، تكمم الأفواه ، بحجة المحافظة على سمعة الوطن ، وتقيد الحريات بدعوى ضرورة الالتزام الوطني ، وتنفرد بالحكم بذريعة أن الوطن يعيش في ( حالة الطوارئ ) ، أما من يلتفون حولها من جماعة ( علي بابا ) ، وهم بمختلف المسميات وفي جميع الميادين ، فهم يبادلونها المصالح بإخلاص الشركاء الأوفياء ، وعلى سبيل المثال ، فإن الإعلاميين منهم يساعدون هذه الطبقة على مدّ قرونها ، وستر عيوبها ، وهم يسبحون بحمدها آناء الليل وأطراف النهار ـ والجلالة لله ـ فيصمون الآذان بمديحهم لها ، وإذا تسلل صوت ليعلن رأياً على الفضائية ( الوطنية ) بصوت الناقد الخجول ، فإنهم يعملون على تخليصه من موقفه المحرج ( بكسر الراء وفتحها ) وذلك بكتم صوته بحجة انقطاع الاتصال ، معللين تصرفهم بضرورة المحافظة على السمعة الوطنية ! أما الاقتصاديون ـ وأنا أقصد جماعة ( علي بابا ) وليس غيرهم ـ فإنهم لا يدعون وسيلة في سبيل اللعب بعقول الناس والتسلل إلى عواطفهم إلا طرقوها من أجل الاستحواذ على النزر اليسير مما في جيوب أبناء الوطن الذين تعاني غالبيتهم العظمى من الفقر في مثل هذه البلدان التي هي موضوع حديثنا هذا ، فتراهم يتوسلون إليهم تارة ، ويعرضون عليهم العروض التجارية المحسُوْبة ـ أو المُحَوْسَبَة ـ لصالحهم سلفاً تارة أخرى ، فإذا قيل لهم : اتقوا الله في جودة البضاعة وأسعارها ، أخذتهم العزة بالاثم ، ولوحوا لك بسيف ( الصناعات الوطنية ) الحادّ ، مستخرجين ما شاؤوا من الشعارات الوطنية ليسوقوها على المستضعفين في عبوات المنتجات ، وكأن الوطنية لهم حق مكتسب دون أن تكون أيضاً واجباً يُحتسب !
أما المعارضة التي تلبس ثوب ( الديمقراطية ) الفضفاض ، وأنا هنا أقصد ( تجار المواسم ) بالذات ، ولا أقصد كل معارضة ـ فإنني أرى أن المعارضة ليس حقاً وطنياً يجب أن يكفله القانون فقط ، بل أرى أن تسهيل عملها وصيانة حقوقها هما من أهم واجبات الحكم ، ليس باعتبار أعضائها مواطنين فحسب ، بل لأنهم يشاركون في تطوير الأداء السلطوي بما يسلطونه عليه من أضواء النقد البناء ـ فإن ( تجار المواسم ) هؤلاء تراهم ينامون دهراً ، فإذا أفاقوا ينطقون كفراً ، وذلك يعني أنهم يختفون عن الأنظار حينما يحلوا لهم ، من منطلق الخوف ، من جور السلطان ، ويظهرون إلى العلن حينما يتوقعون أن سوقهم رائجة وبضاعتهم مطلوبة وذلك من منطلق الطمع ، وبموافقة صاحب الصولجان ، وهم في مثل هذه الحالة إذا خاصموا فجروا ، وهم مستعدون في سبيل كسب الموسم أن يرتكبوا الموبقات ، وشماعة الديمقراطية جاهزة ليعلقوا عليها ما يرتكبونه من الخطايا ، حتى وإن وصل بهم الأمر إلى الاستعانة بالغريب ، أو اللجوء إلى التخريب ، أو المساعدة على اختطاف الكرة من يد رئيس منتخب ودحرجتها بشماتة نحو أقدام العسكر ، قبل أن ينتهي الموسم ، فيربح منهم من ربح ، ويخيب منهم من يخيب ، ويختفوا جميعاً عن الأنظار بانتظار موسم آخر .
ما أجمل المشاعر الوطنية ! فهي زبدة الانتماء ، وما أعظم الممارسات الديمقراطية ! فهي تجسيد الإخاء ، ولكن هذه المشاعر وتلكم الممارسات لا يمكن لها أن تنمو إلا في تربة من الصدق ، وفي مناخ من الوفاء ، فإن لم تكن هذه التربة ، ولم يكن ذلك المناخ ، فإننا ـ وللأسف الشديد ـ سنعاني من ( وطنية ) زائفة و( ديمقراطية ) مزورة !
