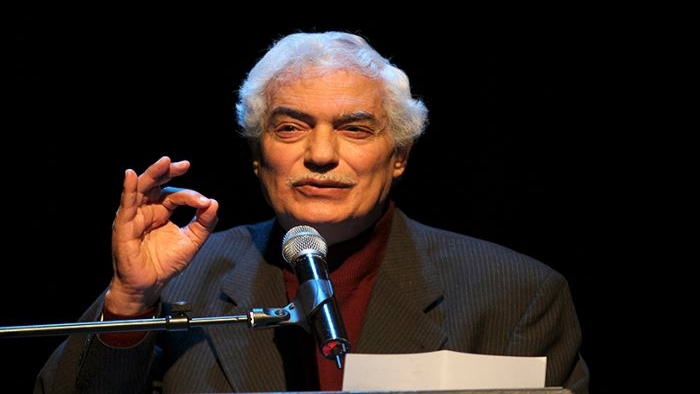
قال شاعرنا محمود درويش مقولته الشهيرة : ( على هذه الأرض ما يستحق الحياة : تردد إبريل .. ) ، وهذا صحيح ، ولكن شهر إبريل ، أو ما يسمى باسم ( نيسان ) في بلاد الشام ، ومنها فلسطين ، قد عاد في هذا العام ليس بنضارة الحياة التي تبدو في أزهار الأقحوان وشقائق النعمان فحسب ، بل بغمامة من الأحزان ، كدّرت نفوس عشاق الشعر والأدب من الفلسطينيين والعرب ، وأحباب الشاعر الفلسطيني الكبير أحمد دحبور .
فما أن انتصف نهار التاسع من شهر نيسان من هذا العام (2017 ) حتى كان جمع من المثقفين ورجال السياسة والمجتمع ، يوارون على ضوء نهار بائس وشمس حزينة جثمان الشاعر الفلسطيني الفقيد ، وذلك في اليوم التالي لوفاته ، وهو الذي أقسم ذات يوم ، في أغنية كتبها ،على أن يزرع ( غصن اللوز الأخضر ) كرمز للحياة.
وبرحيل هذا الشاعر المبدع تكون الساحة الثقافية الفلسطينية ، قد فقدت ركناً شامخاً من أركانها ، وعلماً من أعلامها ، وهو الذي كتب لفلسطين ، وأنشد للثورة ، حتى أضحت كلماته أغنيات تتردد على ألسنة الثوار وشفاه الأحرار .
والمتابع لسيرة ومسيرة شاعرنا الذي ولد قبل واحد وسبعين عاماً في حيفا ، قبل أن يغادر ( حيفاه ) مع أفراد أسرته ، في سن العامين لاجئاً إلى لبنان ـ بدل إطفاء شمعتي عيد ميلاده كما قال متحسراً ـ ومن لبنان إلى حمص ، يدرك أن هذا الشاعر يجسد حياة الإنسان الفلسطيني اللاجئ بكل أبعادها ، فهي تعكس التشرد والألم والفقر، كما أنها تعكس الانتماء والثبات والعطاء ، فكان لهذا المزيج من المسميات ـ التي التقت في حياة الشاعر ـ أن يجعل منه رمزاً للعصامية ، من ناحية ، وهو الذي لم يتهيأ له من التعليم النظامي الكثير ، فعمل على تثقيف نفسه ذاتياً ، كما جعل مزيج المسميات هذامن شاعرنا أحمد دحبور رمزاً للإبداع والوفاء من ناحية أخرى
ولعل ثقل هذه الحياة الممزوجة بمرارة اللجوءهو ما تعكسه بوضوح عناوين مجموعاته الشعرية التي صدرت على مدى عطائه المديد، حيث يمكننا أن نتبين ـ بغير عناء ـ مدى الإيحاء الذي تعطيه عناوين مجموعاته الشعرية عما تتضمنه هذه المجموعات من انعكاس لحياة الإنسان الفلسطيني الشريد الطريد : ( الضواري وعيون الأطفال ) ، ( حكاية الولد الفلسطيني ) ، ( طائر الوحدات ) ، ليس هذا فقط ، بل إن أسماء بعض تلك المجموعات الشعرية تعكس الحالة الشعورية التي انتابت المشرد الفلسطيني وحالة الضياع التي كان يشعر بها نهاراً ، وتؤرقه ليلاً ، في البحار والقفار ، حيثما سار وأينمااتجه : ( اختلاط الليل والنهار ) ، ( واحد وعشرون بحراً ) ، ( هنا وهناك ) ، ليصل من خلال هذه العناوين إلى النتيجة المعروفة منذ البداية ، والتي يعكسها عنوان مجموعة الشعرية ـ المتأخرة ـ التي تشير إلى أن جيل الشاعر هو ( جيل الذبيحة ) !
ومع هذا ، فقد قُدّر لأحمد دحبور أن يتخلص ـ ولو جزئياً ـ من حالة الشتات والضياع ، وذلك بعودته إلى ( الجزء المتاح من الوطن ) كما أراد أن يصف عودته ، ليس ذلك فقط ، بل إن الحظ ساعده ، في هذا الليل العربي الدامس ، ليل الهزائم المتلاحقة،على أن يصل إلى محبوبته ( حيفا ) دون أن يعود إليها ، كما وصف زيارته لها ، ولكن ذلك كله لم يخلص شاعرنا مما كان يعانيه ، حتى لحظاته الأخيرة ، وهو علمه المؤكد ـ على اعتبار ما يراه ـ بأنه لن يحظى بما حظي به إميل حبيبي ، وهو أن يدفن في ثرى مدينته الأم ، وأن يكتب على ضريحه : باق في حيفا!
