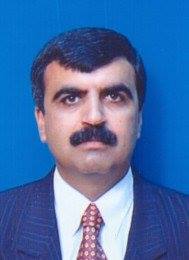
عندما قرأنا قصيدة الشاعر العربي حافظ إبراهيم ( اللغة العربية تنعى حظها ) في المقرر المدرسي عجبنا أشد العجب من ( تجني ) الشاعر على أبناء العربية البررة ، كيف لا نعتبرهم كذلك وهم لم يتوانوا عن التحدث بهذه اللغة والتأليف بها وجعلها لغة الدراسة والتدريس في المدارس ولغة التواصل في المراسلات ووسائل الإعلام ، ذلك بالإضافة إلى ما تحاط به عندهم من هالة التقديس باعتبارها لغة القرآن الكريم ، فما الداعي لما يقوله هذا الرجل ؟!
ولكننا ، ونحن نرى ما آل إليه حال اللغة في أيامنا هذه ، وموقف العقوق الذي يقابلها به الكثير من أبنائها ندرك كم كان هذا الرجل في ذلك الحين على حق ، بل نشعر أنه ـ وبحسّ الشاعر وحدسه ـ نظم نبوءته التي رآها قبل عشرات السنين في أبيات هذه القصيدة التي تنطبق على حالنا مع لغتنا في وقتنا الراهن ، أكثر مما كانت تنطبق على حال أسلافنا معهذه اللغة في ذلك الزمان!
وكيف لا يكون على حق ونحن نرى اللغة رأي العين وقد ألمت بها النوائب والمصائب ، وتشكو خذلان أبنائها حتى تصل شكواها عنان السماء!
فالناظر إلى الغالب الأعم من الجامعات العربية مثلاً يجدها قد جنحت إلى تدريس طلبتها باللغات الأجنبية ، وخاصة في التخصصات العلمية ، متجاوزة بهم لغتهم التي طالما تردد صدى كلماتها في معاهد العلم ومجالس الفكر في الأندلس والقاهرة وبغداد وغيرها ، وحجة هذه الجامعات أن اللغة العربية لم تعد لغة العلوم في زماننا ، حيث يتناسى القائمون على هذه الجامعات أن لغتنا العربية قد أثبتت جدارتها في أن تكون لغة لتدريس العلوم في الجامعات التي سعت إلى هذا بجدّ واجتهاد كجامعة دمشق مثلاً !
ولم يكن الجنوح إلى اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية في الجامعات فقط ، بل إن المدارس في الكثير من بلداننا أصبحت شريكة في هذا الخذلان ، حيث أصبحت تدرس طلبتها اللغة الأجنبية منذ الصف الدراسي الأول ، لتكون شريكة لغتهم الأم من حيث الاهتمام ، وذلك بحجة زيادة استعدادهم لدراسة العلوم بلغة العلم ، حيث يتجاهل أصحاب القرار أن ذلك قد يضعف الطفل في اللغتين معاً ، وأن الطلبة الذين درسوا اللغة الأجنبية من الصف الخامس فما فوق ـ في السنوات السابقة ـ كانوا أكثر نجاحاً فيهما مما نشاهده في هذه السنوات!
وليت هذا الداء ، وما يجلبه من عظيم البلاء قد توقف عند هذا الحدّ ، ولكنه في بعض البلدان العربية ـ وللأسف ـ شمل حتى مواقع القرار ،وعلى أعلى المستويات ، ولن أسمي بلداناً بعينها ، ولكني سأذكر أن وزيرة في إحدى البلدان العربية قد صرحت تصرحاً يخلو من الحكمة ـ بعكس اسمها ـ حين أعلنت أن الحديث باللغة العربية يتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسمها!
أما بعض المثقفين ، فإنهم يعتقدون أن ترقيع عباراتهم بكلمات أجنبية هو السلم الذي يصعدون من خلاله إلى منصة الثقافة ، وأقول ( ترقيع ) لأن هذه الكلمات تبدو في سياق الحديث كما تبدو الرُّقع السوداء في الثوب الأبيض ، ولم يتوقف الأمر على المحادثات الصوتية ، بل انتقل الأمر إلى رموز الخطاب المكتوبة من خلال ما يعرف في لغة التواصل عبر الإنترنت والرسائل الإلكترونية بـ ( العربيزي ) !
وإذا كانت الحالة على هذا النحو مع حماة اللغة ودعاة الثقافة وأرباب العلم ، فلا عجب في أن نجد التهاون في اللغة لدى العوام ، ومنهم الوالدان اللذان يطلقان على أبنائهما الأسماء الأعجمية الغريبة ، وبعض العمال الذين لا يترددون في تداول مفردات وتسميات مشغّلهم الأجنبي ، وكذلك التجار الذين يعتقدون أن كتابة لافتاتهم التجارية بخط أجنبي أو تسمية محلاتهم بأسماء أعجمية سيجلب لهم الحظ أو الزبائن أو كليهما معاً ، فيا للعجب!
إن التهاون في شأن اللغة الأم ليس هو مجرد خذلان بحق الركن الأساس من أركان الهوية القومية في ميدان التنافس بين الحضارات ، أو هو إضعاف لهذا الركن فقط ، بل إن لهذا التهاون ما له من انعكاس على المسيرة التربوية والتعليمية والعلمية والثقافية ، فهل نتنبه إلى هذا الأمر ، ونعطي لغتنا الجميلة ما تستحقه من الاهتمام والتكريم ؟ وهل سيأتي ذلك اليوم الذي نشعر فيه حقاً أننا لم نعد بحاجة إلى قصيدة شاعرنا حافظ إبراهيم إلا للدراسة اللغوية فقط ، أم أننا سنفاجأ ذات يوم بشاعر حريص على اللغة وقد نظم ـ هذه المرّة ـ في حالنا قصيدة عنوانها ( اللغة العربية تنعى أبناءها ) ؟!
