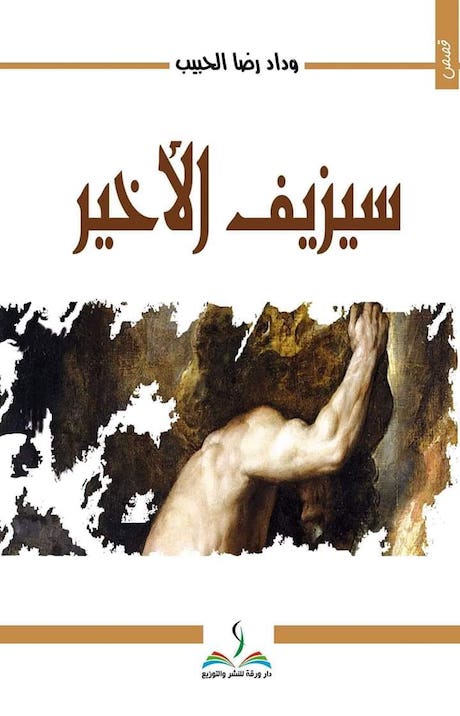
مُمتِعة هي حياة العاصمة بين جُدرانها العالية ، آلاف المحلَات، قاعات السنيما والمَسرح، دور الشَّباب والثقافة وآلافُ النّوادي، مهرجانات وملتقَيات ،قِصص وحِكايات لم أرَ منها أيّ شيءٍ، ولمْ أعلمْ حتى بوجُودها. اختزلتُ العاصمة ذلك الوحْش البشريُّ في المَبيتِ الجامعيِّ ، الجَامعة والحافلة التي تمضِي بي كلّ يوم ذهابا ثمّ إيّابا. ثمّ اختزلتُ المبيت الجامعيّ في الغرفَة التي أسكنُها كما اختزلتُ الجامعة في القاعات التي أدرسُ فيها فقط. عدا ذلكَ، لم يكنْ لي أيّ اهتمام بأيّ شيء، ففكرت أن ألتقيَ بمديرةِ المبيت الجامعي تُرْعبني. شرطيّ المرورِ كابوسٌ يوميّ يُؤرّق حياتي. عند وصولي إلى الجامعةِ كان عليّ أن أمرَّ من باب السيَّارات أو أسترِق اللَّحظة المناسبة للدُّخول إلى الحرمِ الجامعيّ. أمّا داخل الجامعة فالوُصول إلى قاعات الدرس يحتاجُ إلى خريطة متماسكة و خِفّة في الحركةِ وابتعاد عن الأماكنِ الملغّمة والمشبُوهة. الهدفُ المرْسوم واضحٌ ويجبُ الوصول إليهِ بسلام.. يعني الوصول إلى قاعة الدَّرس والاختباءِ هناك إلى حين حضُور الأستاذ المُحاضر طبعًا إذا وافق هذا الأخير على مُتابعتي لمحاضَرته فالقانُون واضحٌ وصارم " يُمنع منعا باتا حُضور الفتيات المُحجّبات أو ما يسمى باللِّباس الطائفيّ" و نحن دولةُ قانُون و تطبيقهُ في مؤسّساتنا من المسَلّمات. هذا ما كان يردّده حارس الجامعة اللّعين وقد ضمّ يديه إلى صدره ورفع رأسه إلى السّماء كأحمق يردّد كلمات أغنية أعجميّة لا يتقن لغتها ولا يفهم معانيها ." حسونة "هكذا كان اسمه .مذ أن عرفته وهو بنفس الهيأة الرثّة وبنفس الشَّعر المنفوش كقنٍّ للدّجاج. كان طويلا بلا نهاية ، هزيلا حدّ الموت ، صوته كنباح الكلاب وعشيقاته بعدد الذّباب.. ويزداد عددهنّ باقتراب فترة الامتحانات فلا حدود لنفوذه من باب الجامعة إلى داخل قاعات الامتحانات مرورا بغرفة نسخ الاختبارات لينتهي بأوّل مستطلع على أسماء النّاجحين وخاصة النّاجحات. من يستطيع أن يتجاهل سطوة السيّد حسّونة أو حسونتي كما تسمّيه الفتيات بأصواتهنّ المتأجّجة بالأنوثة المصطنعة، فيهيج و يحمرّ وجهه ليزيد طولا إلى طوله؟ كنت ألاحظ كلّ ذلك كالبلهاء. كان عقل الفتاة القادمة من مدينتي البسيطة غير قادر على استيعاب كلّ هذا التصنّع. مسرح داخل المسرح والكلّ يقوم بدور الإخراج على وقعه الخاص بفوضى تشبه سمفونية جمعت بين " المزود " التونسي و" الموزيكا " الخلاديّة ومقطوعات بيتهوفن والرّاب و الرّاي والموسيقى الصّوفية التركيّة ولما لا بعض الأوبرا الايطاليّة. عالم من الجنون يتراقص أمامي في نفس المكان ونفس الزّمان وأنا أقف وحيدة بلا خريطة ولا أستاذ موسيقى يبيّن لي النّشاز من العذب. أليست أصوات الكلمات موسيقى؟ والحركات رقص على أنغام موسيقانا الدّاخليّة؟ وحتى الصّمت ضرب من الموسيقى؟ كنت أخشى أن أضيع ايقاعي الخاص وسط كلّ هذه الفوضى، فتشبّثت أكثر فأكثر بحجابي وغرفتي وصمتي.
" دُمْدُمْ " هكذا أَطلقَ عليهِ الطّلبة . السيِّد " الهادي " كاتب عام الجَامعة رجل طويل القامَة نحيلٌ كالظلِّ أسمرُ البشرة قليلُ الشَّعر .يضَع نظَّارات بِلوريَّة سميكَة تجعلُ من عينيْه ثُقبين غائِرين بلا عدَسة ولا بياضِ عيْن. لهُ شاربٌ كبير يُغطي شفتيْه فأتساءل كيف يأكل وهل تُقبّله زوجته؟ صامتٌ حدّ الرِّيبة كثيرُ الحَركة بلا روحٍ. هو هُنا وهناك وفي كلِّ مكانٍ في نفس الوقت. يُرعبنا بمجرّد ذِكره. كثُرت حوله النُّكت والشُّبهات . لكِنّه ظلَّ عدوّ المُحجبات اللَّدود.
أَذكر ذات صباح وقفتُ عند الجِهة المُقابلة للباب على الساعة السابعة و نصف. الحارس يحدّث إحدى الفتيات ويداعِب خصَلات شعرِها. مشهدٌ رومنسي بامتياز عِند بابِ الجامعة. جيدٌ جدا فرصة سانحة للدُّخول فما هو فيه سيُشغله عن الدُّنيا وما فيها. ذكرت اسم الخالِق في سرّي وتمتمتُ ببضع كلمات من القرآن وانطلقتُ نحو الباب. كان يجِب أن أمرَّ خلْف الحارس بسرعة ودون صوت كالنَّسيم تماما. وهكذا مررتُ. نجحتُ في الدُّخول. بسرعة انعطفتُ مع أوّل ممرٍّ هدفي القاعة الثالثة بالممرِّ الثاني على اليمين. كنت أمضي إلى الأمام لا أجرؤ على الالتفات يمنة أو يسرة. خُطتي تقتَضي السُّرعة والدقّة. بالممرِّ الذي أنا فيه عدّة قاعات متتاليةٍ وآخره ممرّ على اليسار وآخر على اليمين وهو هدفي. بينما كنت أسابق الثّواني قبل ممر اليَسار مباشرة وفي لحظة واحدة اصْطدمت بشيء أسوَد طويل لأجد نفسي بين أحضانِه. مِتّ من شدّة الخوفِ لاعتقادي أنَّه السيِّد " دُمْدُمْ " فقد كان يرتدِي طيلة الشِّتاء نفس المِعطف الصوفيّ الأسود الطَّويل . تراجعتُ بِسرعة بل تراجعنا لتكتشف كلّ واحدة منَّا أنَّها اصطدمتُ بشقيقتِها في عمليّة الافلات الصباحيّة من مخالبِ الحارس والكاتب العام . لم تدُم الواقعَة إلا ثوان استرقنا الابتسامات وتحدَّثنا بلمحة من الأعْين بما يمكن أن يُقال في ساعات ومضى كلّ منّا إلى قدره. وصلتُ أخيرا إلى الممرّ المنشودِ و قبل بلوغي القاعة أشار إليّ أحدُ الطلبة بيده محذِّرا بوجود الخطر فانعطفتُ يسارا واختبأت في الحمَّام. بقيتُ هناك لأكثر من عشر دقائق. أختَلس النَّظر من الثقوب الجانبية بين الباب والجدار. لم أستطِع أن أتأكّد من زوال الخطرِ ورحيل العدوِّ حتى اقتربتْ منِّي امرأة في الخمسين من عمرها ترتدِي ميدعة بيضَاء وقد بان على وجهها تعبُ السنين وقسوة الأيَّام تحمِل مكنسة وابتسامة أمّ حنون . قالتْ " انتظري، سأتأكّدُ من رحيلهْ " خرجتْ تردّد كلمات أغنية من الزّمن الجميل ثم عادت " اذهبي الان... لكن الحياة يا ابنتي ليست هذا..." سكتَتْ وسكتُّ. رأيتُ في عينيها حزنا عميقا وحكمةً لو خصَّصتُ وقتي للحديث معَها واستماع لكلماتِها بقلبٍ مفتوحٍ وعقل نابضٍ لكان أفضل من محاضرةٍ لا أُدرك منها إلا بِضع كلمات بسبب تشتُّت ذهني و خوفي من دخُول المسؤول في أيّ لحظة . قلتُ " ربّي يهدي الجميع " واندفعتُ نحو القاعة سعيدة بوصولي وكأنّ أبواب فلسطين فُتحت لي بل وكأنني حرُّرْتها من المستعمرٍ إلى الأبد. جلستُ أتنعّمُ بانتصاري. تأخّر الأستاذ ربع ساعة ثم نصف ساعة ثم أيقنّا أنّه لن يحضُر اليوم. بنفس طريقة الوصُول كان عليَّ المُغادرة.